لماذا يريدُ اللهُ مِن هذهِ المخلوقاتِ بما فيها الملائكةُ والبشرُ أن تعبدَه ؟ ماذا يستفيدُ مِن هذهِ العبادةِ وهوَ الغنيُّ عنها ؟
ارجو منكم المساعدة فالشكوك تعذبني وانا امرأة ملتزمة واحب التدين لكن الشك ينغص علي علاقتي مع خالقي ويسبب لي عدم التوجه القلبي في العبادة سؤالي هو .. لماذا يريد الله من هذه المخلوقات بما فيها الملائكة والبشر ان تعبده ؟ ماذا يستفيد من هذه العبادة وهو الغني عنها انا اعرف ان الفنان مثلا حين يرسم لوحة ما او يعمل لحنا ما فهي لحاجة في نفسه يعبر عنها بهذه الطريقة ويريد من الاخرين ان يروا ما عمل ويعجبوا به اما رب العالمين فهو غير محتاج الى ذلك ثم لماذا هذا المدح والثناء في الادعية فهو ليس بحاجة الى اعجاب مخلوق ضعيف لا يساوي شيئا امام عظمته وجبروته .. حين اقرأ في القران انه ماخلق السموات والارض الا بالحق اقول ما هو هذا الحق ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ما يتبادرُ في ذهنِ الأختِ مِن إشكالاتٍ حولَ العبادةِ لهُ علاقةٌ بتصوّرٍ مشوّهٍ لمفهومِ الدينِ والعبادةِ عندَها، ولذا سوفَ تكونُ الإجابةُ محاولةً لرسمِ مفهومٍ للعبادة ِتنتفي معهُ مثلُ هذهِ الإشكالات.جاءَ في الخبرِ أنَّ رجلاً سألَ الإمامَ الصادقَ (عليهِ السلام) قالَ: لمَ خلقَ اللهُ الخلق؟ فقالَ: (إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى لم يخلِق خلقَه عبثاً، ولم يترُكهم سدىً، بل خلقَهم لإظهارِ قُدرتِه، وليكلّفَهم طاعتَه، فيستوجبوا بذلكَ رضوانه، وما خلقَهم ليجلبَ منهم منفعةً ولا ليدفعَ بهِم مضرّةً، بل خلقَهم لينفعَهم ويوصلَهم إلى نعيمِ الأبد) (بحارُ الأنوار 5/314). منَ الواضحِ أنَّ كلَّ ما في الكونِ سُخّرَ مِن أجلِ الإنسان، كما أنَّ الأديانَ والرسالاتِ جاءَت أيضاً مِن أجلِ الإنسان، فالسؤالُ هُنا إلى أيّ شيءٍ خُلقَ الإنسان؟ فالإنسانُ هوَ أسمى ما في عالمِ الوجودِ والخلق، وعليهِ لا وجودَ لشيءٍ يمثّلُ غايةً للإنسانِ سوى اللهِ الخالقِ لكلِّ شيء، ومِن هُنا كانَت عبوديّةُ الإنسانِ للهِ هيَ المرتبةُ العاليةُ التي يتشرّفُ بها الإنسان، وقد بيّنَ القرآنُ هذا الأمرَ في قولِه تعالى: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعبُدُونِ﴾، وبذلكَ يجبُ أن تمثّلَ العبوديّةُ هدفاً سامياً وقيمةً عُليا للإنسانِ، ولكي نفهمَ ذلكَ لابدَّ مِن بعضِ المُقدّمات. نحنُ هنا لا نحاولُ أن نُثيرَ الأمرَ بشكلِه التقليدي، الذي يتناولُ تعريفَ العبادةِ في اللغةِ والاصطلاح، ومِن ثمَّ مناقشةِ الآراءِ وترجيحِ الأقوال، وإنّما نحاولُ التعرّفَ- وبشكلٍ مُباشر- على حِكمةِ العبادةِ وحقيقتِها، والفلسفةِ الكامنةِ فيها.في البدءِ، لا يمكنُ أن تتضمّنَ العبادةُ مفهوماً سلبيّاً، لا مِن جهةِ العبدِ ولا المعبود، لأنَّ اللهَ غنيٌّ بذاتِه لذاتِه، غيرُ مُحتاجٍ لخلقِه: ﴿وَمَن يَبخَل فَإِنَّما يَبخَلُ عَن نَفسِهِ وَاللهُ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ الفُقَراءُ﴾. فمنَ الواضحِ إذاً، أنَّ اللهَ لا ينتفعُ بعبادةِ العبد، بل العبادُ هُم الذينَ ينتفعون، ومِن هُنا لا تكونُ العبادةُ حقيقةً سلبيّةً بالنسبةِ للإنسانِ أيضاً، أي بمعنى أنَّ اللهَ لم يخلِق الإنسانَ لكي يستعبده، ويفرضَ عليهِ ما يقيّدُه.ولذا يجبُ علينا البحثُ عن معنىً للعبادةِ يستقيمُ معهُ التوحيد، وتنسجمُ بهِ فطرةُ الإنسان، فالعبوديّةُ في الدلالةِ العُرفيّةِ تتناقضُ معَ الحُريّةِ، فكيفَ يكونُ الإنسانُ عبداً وفي الوقتِ نفسِه حرّاً؟ وهل قيمةُ الإنسانِ في عبوديّتِه أم في حرّيّتِه؟ هذهِ الأسئلةُ يمكنُ أن تقودَنا إلى إيجادِ فلسفةٍ للعبادةِ يرتفعُ بها التناقضُ وتتحقّقُ بها قيمةُ الإنسان. ولكي نقتربَ منَ العبادةِ بالمعنى التشريعي، لا بدَّ أن نقتربَ أوّلاً منَ العبادةِ بالمعنى التكويني، بوصفِها الأساسَ الذي تبتني عليهِ العبادةُ في التكليف؛ فكونُ الإنسانِ عبداً باختيارِه، يعني بالضرورةِ كونَه عبداً في كيانِه، فلا يكونُ هذا التكليفُ حالةً عرضيّةً لم ترتكِز على الطبيعةِ الإنسانيّة، وإنّما القولُ بأنَّ الإنسانَ بذاتِه عبدٌ، هوَ تعبيرٌ آخرُ عن القولِ أنَّ الإنسانَ كائنٌ مخلوق.وبعبارةٍ أخرى، هل الإنسانُ بذاتِه عبدٌ؟ أم بذاتِه حر؟فإن كانَ الإنسانُ بذاتِه حرّاً، فتكونُ العبادةُ بالمعنى التشريعيّ نوعاً مِن أنواعِ مُصادرةِ الحريّةِ أو تحديدِها وتحجيمِها، لعدمِ وجودِ مُبرّرٍ ذاتيٍّ يدعو الإنسانَ للخروجِ منَ الحُرّيّةِ للعبوديّة، إلّا أن تكونَ هناكَ سلطةٌ فوقيّةٌ، فرضَت الهيمنةَ والقهرَ على الإنسان، إظهاراً للسّلطنةِ والقُدرة، فتكونُ العبادةُ حينئذٍ حالةً سلبيّةً بامتياز، على مستوى العبدِ والمعبود. فعلى مُستوى العبدِ لا تعدو كونَها تحجيماً لمُقدّراتِه وتحديداً لإمكاناتِه، والأمرُ واضحٌ على مُستوى المُفارقةِ العُرفيّة، التي تميّزُ بينَ العبدِ المملوكِ لسيّدِه وبينَ السيّدِ الحُر. أمّا على مُستوى المعبود، فإنّها تكشفُ وبشكلٍ ما، عن حاجتِه ونقصِه لفرضِ الهيمنةِ والسلطنةِ على الإنسان. أمّا القولُ الآخرُ بأنَّ الإنسانَ بذاتِه عبدٌ للهِ تعالى، فإنّه يرتكزُ على حقيقةِ الإنسانِ المخلوق، وهذا الوصفُ هوَ ذاتُه الذي يُحقّقُ معنى العبوديّة؛ فإذا تحقّقَ الخلقُ، فلا يحتاجُ الأمرُ إلى مرحلةٍ ثانيةٍ تتحقّقُ فيها العبوديّةُ التكوينيّة، فالمخلوقُ مُعلّقٌ دوماً بخالقِه، والموجودُ مُحتاجٌ إلى مُوجدِه، بحيثُ يكونُ مُضطرّاً في بقائِه إليه، وتلكَ العُلقةُ الاضطراريّةُ هيَ نفسُها العبوديّة، (وإذا كانَ الإنسانُ قد خلقَه الله، فهوَ إذَن لم يُوجِد نفسَه، ولا هوَ يمدّها بطاقةِ البقاء، ولذلكَ فإنّه موسومٌ بطابعِ (العبوديّةِ الذاتيّة)، النابعةِ مِن كيانِه الطارئ الذي يملكُه اللهُ بكِلتا يديه، وقد وهبَه إيّاهُ بكاملِ مشيئتِه، وسوفَ يأخذُه منه متى أرادَ بكلِّ قوّةٍ وسُلطان، وأيُّ عبدٍ أشدُّ عبوديّةً، وأوسعُ رقّاً مِن هذا الذي لا يملكُ خلقَه، ولا يضمنُ لنفسِه البقاء؟! وفي المقابلِ، أيُّ سيّدٍ أقوى سيادةً وأوسعُ سُلطاناً منَ (الله) الذي يُعطي الوجودَ ويضمنُ البقاء، وإن شاءَ منع؟ وتأتي مِن طبيعةِ هذهِ المُقابلةِ العميقةِ حقيقةُ (الحاكميّةِ) المُطلقةِ للهِ سُبحانَه على البشرِ جميعاً، كما تتحقّقُ طبيعةُ (المحكوميّةِ) الشاملةِ للإنسان، بحيثُ يفرضُ عليهِ العقلُ والضميرُ أن يخضعَ للهِ في كلِّ شؤونِه، وألّا يعملَ إلّا بما يوحيهِ إليهِ سُبحانَه، ويلزمُه في حقليّ الدّنيا والآخرة سواءً بسواء، ذلكَ لأنَّ مجرّدَ تصوّرِ (المالكيّةِ الإلهيّة)، و(العبوديّةِ البشريّة)، كافٍ لإيحاءِ فكرةِ العبادةِ والخضوعِ أمامَ اللهِ تعالى، إذ الفكرةُ هذهِ ليسَت إلاّ تعبيراً عن تلكَ الحقيقة. فالتسليمُ في عُمقِ الشعور، تعبيرٌ عن التسليمِ في عُمقِ الوجود، والطاعةُ في حقلِ الإرادة، تعبيرٌ عن الطاعةِ في حقلِ السننِ الكونيّة، والعملُ وفقَ هُدى اللهِ في التشريع، تعبيرٌ عن العملِ وفقَ هُداه في التكوين، والسجودُ على الأذقانِ اختياراً، تعبيرٌ عن السجودِ في الكيانِ اضطراراً، والصيامُ عن الشهواتِ وهيَ مقدورةٌ، تعبيرٌ عن الصيامِ عن التمنّياتِ وهيَ مُستحيلة، والدينُ، كلُّ الدينِ، انعكاسٌ في الشعور، وفي الإرادةِ عمّا هوَ حقيقةٌ وواقعٌ في اللاشعورِ وفي النظمِ الكونيّةِ فيما وراءَ الإرادة). وهذا الانسجامُ بينَ العبادةِ في التشريعِ والعبادةِ في التكوين، هوَ السببُ الذي يجعلُ الإنسانَ في تكاملِه مُنسجِماً معَ كلِّ الوجود، فإذا كانَ الإنسانُ في واقعِ كيانِه عبداً لله، تكونُ الحُريّةُ حينئذٍ موهبةً ومنّةً إلهيّة، تطوَّلَ اللهُ بها على العباد. والحرّيّةُ بهذا الفهمِ لا يمكنُ أن تكونَ تأسيساً لخياراتٍ تبتعدُ عن حقيقةِ العبوديّة؛ فالحدُّ المُشتركُ، الذي يجمعُ بينَ كيانِ الإنسانِ المُضطرِّ في عبادتِه للهِ وبينَ الحُرّيّة، هيَ المسؤوليّة، والمسؤوليّةُ تعني أن تتحرّكَ الحُرّيّةُ فيما ينسجمُ معَ الطبيعةِ التكوينيّةِ للإنسان؛ لأنَّ الحريّةَ ليسَت مُطلقَ الترجيحِ بينَ الخيارات، وإنّما الحُرّيّةُ هيَ ترجيحُ الأصلحِ الذي ينسجمُ معَ طبيعةِ الإنسانِ العابدِ بكيانِه لله، وإلّا تكونُ الحُرّيّةُ عقبةً حقيقيّةً في مسيرةِ الإنسانِ التكامليّة؛ لأنَّ بإمكانِ الإنسانِ أن يختارَ بحُرّيّتِه السيرَ عكسَ اتّجاهِ السّننِ الكونيّة. صحيحٌ أنَّ الإنسانَ حرٌّ في أن يكونَ عبداً أو لا يكون، ولكنّهُ مسؤولٌ، فالعبادةُ على مُستوى التشريعِ، هيَ نوعٌ منَ الإقرارِ بكونِه مخلوقاً، وهذهِ الحقيقةُ هيَ بدايةُ الطريق، لسعي الإنسانِ نحوَ اللهِ الخالق.وبهذا بدأنا نقتربُ مِن معرفةِ حِكمةِ العبادة، فإذا بدأنا بالآيةِ القرآنيّة: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعبُدُونِ﴾، وجَدنا أنّها تشيرُ للعبادةِ على مُستوى التشريعِ وليسَ التكوين، وهيَ ترسمُ بذلكَ فلسفةَ خلقِ الإنسانِ وحِكمةَ وجودِه.وإذا تمعنّا فيها، نجدُ أنَّ هناكَ مُقابلةً بينَ كلمةِ الخلقِ وكلمةِ العبادة، فإذا عرَفنا عُمقَ معنى كلمةِ الخلقِ نعرفُ عُمقَ معنى كلمةِ العبادة، وذلكَ لأنَّ العبادةَ جاءَت كنتيجةٍ طبيعيّةٍ لخلقِ الإنسان، فمتى ما كانَ هناكَ خلقٌ، كانَت هناكَ عبادة، فكأنّها لازمٌ ذاتيٌّ لا تنفكُّ عن الخلق، ومنَ المعلومِ أنَّ كلمةَ الخلقِ لها معانٍ، فأيُّ معنىً مِن معاني الخلقِ يمكنُ أن يُقابلَ مفهومَ العبادة، أو يُحقّقَ مفهومَ العبادة؟هنالكَ ثلاثُ معانٍ للخلق، وهيَ: المعنى الأوّل: أنَّ الخلقَ أمرٌ واقعيٌّ ليسَ وهماً وخيالاً، بخلافِ المدارسِ السفسطائيّةِ والمثاليّة التي شكّكَت في حقيقتِه، فالموجودُ حقيقةٌ مُتمثّلةٌ في الخارج، وأقربُ طريقٍ إلى معرفتِه هوَ التنبّهُ إلى واقعِ وجودِه، والاعترافُ بأنَّ للإنسانِ كياناً وحقيقةً، وهوَ بدايةُ تأسيسِ قيمٍ حياتيّةٍ تؤكّدُ حقَّ الإنسانِ في الوجود.المعنى الثاني: أنَّ كيانَ الإنسانِ ووجودَه قائمٌ بالله، ممّا يعني أنَّ وجودَه حقيقةٌ طارئة، تحتاجُ دوماً في وجودِها إلى المُوجِد، ونستفيدُ مِن هذا المعنى العبوديّةَ بالمعنى التكويني، بشكلٍ أوضحٍ منَ المعنى التشريعي.المعنى الثالث: أنَّ الإنسانَ ما دامَ مخلوقاً، فهوَ لا يزالُ ناقصاً، يعيشُ حالةً منَ الضعف: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعفٍ ﴾، والشعورُ بالضعفِ والفقرِ والحاجة، هوَ بدايةُ السعي لإكمالِ النقص، لأنَّ الذي خلقَه مِن لا شيء، قادرٌ على أن يزيدَه كمالاً، ويباركَ لهُ في قدراتِه: ﴿وَاسئَلُوا اللهَ مِن فَضلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً﴾، والطريقُ إلى إكمالِ النقصِ هوَ الرجوعُ إلى اللهِ تعالى، والطلبُ منه والتقرّبُ إليهِ سبحانَه ﴿وَقالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ﴾، وهُنا ربطٌ واضحٌ بينَ الدعاءِ والعبادةِ، وبينَ طلبِ الحاجةِ والاستجابة، والحاجةُ دليلُ النقصِ، والاستجابةُ إكمالٌ للنّقص. وكلُّ هذه المعاني تُحقّقُ مفهومَ الخلقِ (وما خلقتُ)، فيمكنُ أن يقال: الخلقُ هوَ هذا الذي تراهُ ماثِلاً أمامَك، أو: الخلقُ هوَ الحقيقةُ التي تحتاجُ إلى خالق، أو: الخلقُ هوَ الناقصُ الذي بإمكانِه أن يتكامل.بعدَ أن تتّضحَ هذهِ المعاني، نجدُ أنَّ معنى الخلقِ المُقابلِ للعبادةِ في الآيةِ المُباركة هوَ المعنى الثالث، أي أنَّ الإنسانَ مخلوقٌ له قابليّةٌ على النموِّ والتكامل، فتصبحُ حقيقةُ العبادةِ هي: تكاملُ الإنسانِ والعروجُ به في مدارجِ الكمال، فالآيةُ تعني أنَّ اللهَ لم يخلِق الإنسانَ إلّا لتحقيقِ لذلكَ الهدف، فإذا كانَ الإنسانُ يُمثّلُ محورَ الخلق، وكانَ تكاملُ الخلقِ مِن أجلِ الإنسان، فلا بدَّ أن يكونَ للإنسانِ تكاملٌ خاص، وهذا سرُّ دُعاءِ الأنبياءِ والرسلِ للعبادة، لأنّها الطريقُ الذي يُحقّقُ للإنسانِ تكاملَه، بعدَ ربطِه باللهِ مصدرِ كلِّ كمال. والارتباطُ باللهِ يتحقّقُ عبرَ تمسّكِ العبدِ بأسماءِ اللهِ الحُسنى، قالَ تعالى: ﴿وَللهِ الأَسماءُ الحُسنى فَادعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلحِدُونَ فِي أَسمائِهِ سَيُجزَونَ ما كانُوا يَعمَلُونَ﴾ فكلُّ ما في الوجودِ هوَ مظهرٌ لأسمائِه وهو فعلهُ ولا كيفَ لفعلِه. فاسمُ العليمِ، القديرِ، الرحيمِ، الحكيم، ... وغيرِ ذلكَ منَ الأسماءِ نجدُها ظاهرةً في خلقِه، فاللهُ يخلقُ بعلمٍ، ويصنعُ بقُدرة، ويحكمُ برحمة، ويدبّرُ الأمورَ بحكمة، وبالتالي الأسماءُ هيَ عينُ فعلِه تعالى، والإنسانُ هوَ الذي يرى كلَّ ذلكَ واضِحاً في عجائبِ صُنعِه. وعليهِ يمكنُنا القولُ أّنَّ هذه الأسماءَ هيَ حقيقةُ الوجودِ وسرُّ بقاءِ الخليقة، ولو رفعَ اللهُ هذهِ الأسماءَ لتلاشى الخلقُ وتحوّلَ إلى عدم، إذ كيفَ نتصوّرُ الكونَ من دونِ علمٍ وقُدرةٍ ورحمةٍ وحكمة..، ﴿وَأَشرَقَتِ الأَرضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾، ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ﴾. وحقيقةُ الإنسانِ وكمالهُ في كونِه مظهراً لهذهِ الأسماء، فالإنسانُ يحملُ مقداراً مِن اسمِ العليمِ ما به يعلم، ومِن اسمِ الحيّ ما به يحيى، ومِن اسمِ القديرِ ما بهِ يقدر، ومِن اسمِ الرحيمِ ما بهِ يرحم، وهكذا اسمُ الحكيمِ والسميعِ والبصيرِ وغيرُ ذلكَ منَ الكمالاتِ الوجوديّةِ عندَ الإنسان. ومِن هُنا يمكنُنا أن نجزمَ أنَّ قيمةَ الإنسانِ وسرَّ وجودِه قائمٌ بهذهِ الأسماء، فما يجدُه الإنسانُ في نفسِه منَ العلمِ، والقُدرةِ، والسمعِ، والبصرِ، والحياةِ، والرحمةِ، والإيمان... هيَ مِن تلكَ الأسماء، لأنّها فعلُ اللهِ في الإنسان، وهيَ حقيقةُ الإنسانِ وسرُّ بقائه، فلو رفعَها اللهُ منه لكانَ نسياً منسيّاً، ولذا لا يمكنُ تصوّرُ الإنسانِ وهوَ مُستغنٍ عن اللهِ في كلِّ كمالاتِه، وإذا فهِمنا العبادةَ على أنّها الطريقُ لتحقيقِ كمالِ الإنسانِ حينَها لا يمكنُ أن نفهمَ وجودَ الإنسانِ بعيداً عن العبادة.بذلكَ فإنَّ الأسماءَ الحُسنى هي التي تُحقّقُ الرابطَ الإيمانيَّ بينَ الإنسانِ وبينَ الله، حيثُ يتمُّ التقرّبُ إلى اللهِ عبرَ هذهِ الأسماء، وهكذا تصبحُ أسماءُ اللهِ الحُسنى هيَ وسيلةُ العبدِ إلى ربِّه، ومناجاةُ اللهِ بهذهِ الأسماءِ ليسَ مِن بابِ ترديدِها لفظيّاً وإنّما مِن بابِ تجسيدِها عمليّاً، فالعبدُ الشكورُ قد ناجى ربَّه باسمِ الشكور، قالَ تعالى: ﴿اعمَلُوا آلَ داوُدَ شُكراً﴾، أي شُكراً عمليّاً وتجسيداً خارجيّاً، وكذلكَ مَن عملَ على محوِ جهلِه بطلبِ العلمِ يكونُ قد ناجى ربَّه باسمِ العليم، قالَ تعالى: ﴿يَرفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ دَرَجاتٍ﴾. ومَن يستغفِر مِن ذنوبِه ويُصبِح تائباً يكونُ قد تقرّبَ إلى اللهِ باسمِ التوّاب، قالَ تعالى: ﴿واستَغفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إليهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾، وهكذا يرتفعُ المؤمنُ بتلكَ القيمِ حتّى يجسّدَ بسلوكِه تلكَ الأسماء، وعليهِ لا يكونُ المؤمنُ جاهلاً بل عالماً، ولا يكونُ عاجزاً بل قادراً، ولا يكونُ قاسياً بل رحيماً، ولا يكونُ ضعيفاً بل قويّاً، ولا يكونُ جاحِداً بل شاكراً، ولا يكونُ أرعناً بل حكيماً، ولا يكونُ ذليلاً بل عزيزاً، ولا يكونُ وضيعاً بل كبيراً، وهكذا غفوراً، ودوداً، توّاباً، برّاً، لطيفاً، حليماً، رؤوفاً، عفوّاً، جميلاً، مُسبّحاً، سيّداً، طيّباً، مِعطاءً، عدلاً، غنيّاً، مُحسِناً، وهّاباً، كريماً، جواداً، رزّاقاً، مُتفضّلاً، حفيظاً، خبيراً، صانِعاً، حامِداً، مُقدّساً، متعالياً على الباطل، متكبّراً على المُتكبّر، مالكاً لزمامِ نفسِه، سميعاً للحقِّ، مُبصِراً للهُدى، سلاماً على مَن حوله، مُهيمِناً على الطبيعةِ، جابراً لكسرِ الضعيف. وهكذا عبرَ التجسيدِ العمليّ والفعلِ الخارجي تصبحُ الأسماءُ طريقاً إلى الله، أمّا الذكرُ القلبي واللفظي، فهوَ ضروريٌّ لتأكيدِ هذهِ القيم واستذكارِها، حتّى تكونَ حاضرةً دوماً في وعي الإنسان. وعليهِ فإنَّ الطريقَ الوحيدَ لتكاملِ البشرِ هوَ معرفتُه تعالى، ومِن ثمَّ معرفةُ أسمائِه، ويتكاملُ الإنسانُ بمقدارِ وجدانِه لتلكَ الأسماء. قالَ تعالى: ﴿وَفَوقَ كُلِّ ذِي عِلمٍ عَلِيمٌ﴾. وبذلكَ ترتفعُ الإشكالاتُ التي تردُ على ذهنِ الأخت، فالعبادةُ هيَ المسارُ الوحيدُ الذي يُحقّقُ الإنسانُ عبرَه التكاملَ الروحيَّ والمادّي، حيثُ لا يمكنُ أن نتصوّرَ كمالاً للإنسانِ بعيداً عن قيمٍ وغاياتٍ تمثّلُ أهدافاً للإنسانِ، ولا يمكنُ أن نتصوّرَ وجودَ قيمةٍ أو هدفٍ بعيداً عن أسماءِ اللهِ الحُسنى، والعبادةُ ليسَت شيئاً آخرَ غيرَ دعوةِ الإنسانِ إلى هذهِ الأسماء، ومِن هُنا فإنَّ تحميدَ اللهِ وتمجيدَه بهذهِ الأسماءِ لا يشكّلُ حاجةً للهِ تعالى وإنّما حاجةً للإنسان، فكلّما يزدادُ العبدُ معرفةً بالربِّ كلّما ازدادَ شوقاً وحبّاً للقربِ منه.
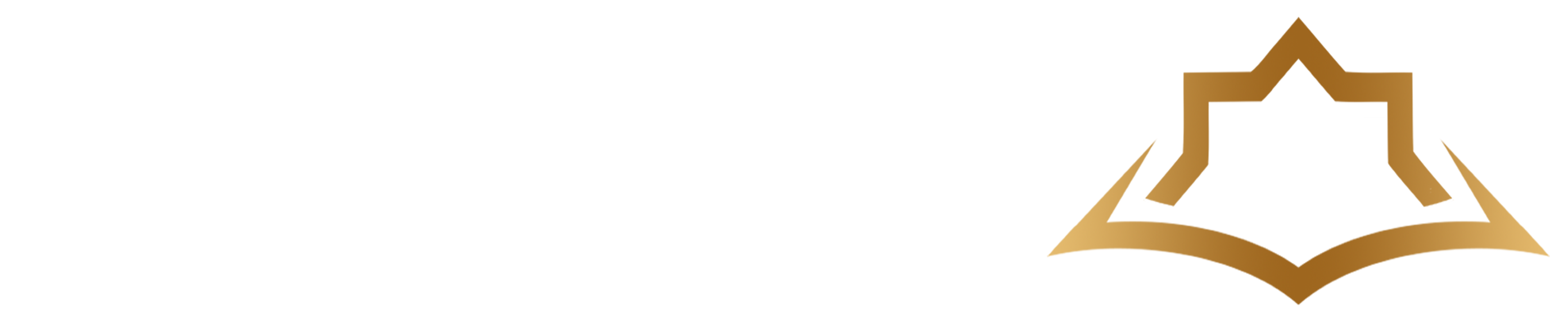

اترك تعليق