اذا جاءَ للمجتهد حُكمٌ مستحدثٌ ليسَ فيه دليلٌ منَ القرآنِ والرواياتِ والإجماعِ مِن أينَ يأتي بالحُكمِ الشرعي؟
السّلامُ عليكم، إذا كانَ المُجتهدونَ مِن أهلِ السنّة، اجتهادُهم باطلٌ على أساسِ الرأي والقياسِ والاستحسان، سؤالٌ: مُجتهدو الشيعةِ يجتهدونَ ويأتونَ بالحُكمِ الشرعيّ على أساسِ النصِّ والرّوايات، اذا جاءَ حُكمٌ مستحدثٌ ليسَ فيه دليلٌ منَ القرآنِ والرواياتِ والإجماعِ مِن أينَ يأتي بالحُكمِ الشرعي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
التمييزُ بينَ المنهجِ الاجتهاديّ عندَ أهلِ السنّة، والمنهجِ الاجتهادي عندَ الشيعةِ ليسَ بالبساطةِ التي تظهرُ في السّؤال، وللوقوفِ على هذهِ المُميّزاتِ يحتاجُ إلى تفصيلٍ لا يسعُه المجال، ولذا سوفَ نعملُ على اختصارِ الإجابةِ بالقدرِ الذي يناسبُ المقام.
لا خلافَ بينَ الشيعةِ والسنّةِ حولَ وجوبِ الرّجوعِ للقرآنِ والسنّةِ لمعرفةِ الأحكامِ الشرعيّة، وإن كانَ هناكَ تباينٌ كبيرٌ فيما يتعلّقُ بعددِ المرويّاتِ الفقهيّةِ عندَ الطرفين، فمنَ الواضحِ أنَّ أهلَ السنّةِ لم يؤمنوا بوجودِ مرجعيّاتٍ معصومةٍ بعدَ رسولِ الله (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلم)، بعكسِ التشيّعِ الذي اعتبرَ أهلَ البيتِ وقيادتهم المعصومةَ الامتدادَ الطبيعيّ للرّسولِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلم)، ومِن أجلِ ذلكَ تمتّعَ التشيّعُ بمميزاتِ العصرِ الذهبي ابتداءً مِن عهدِ رسولِ اللهِ ومروراً بالفترةِ الزمنيّةِ التي كانَ فيها أحدَ عشرَ إماماً معصوماً، فلم يحتَج الشيعةُ إلى إعمالِ النظرِ لاستنباطِ الأحكامِ الشرعيّةِ معَ وجودِ هذهِ المرجعيّاتِ المعصومةِ، ومِن هُنا كانَ الموروثُ الشيعيُّ كبيراً في الرّواياتِ الفقهيّة، فبينما كانَت رواياتُ الشيعةِ في بابِ الفقهِ والأحكامِ الشرعيّة تبلغُ 100 ألفِ رواية، كانَت الرواياتُ المُعتمدةُ عندَ أهلِ السنّة ِفي ما يتعلّقُ بالأحكامِ في حدودِ 500 روايةٍ فقهيّة، وإذا أخذناها معَ المُتكرّرِ والضعيفِ تبلغ ُ4500، يقولُ الدكتور محمّد فاروق النبهان: (وقد جرَت محاولاتٌ لاستقصاءِ الآياتِ والأحاديثِ الواردةِ في الأحكامِ فقيلَ بأنَّ آياتِ الأحكامِ في القرآنِ تبلغُ نحواً من 500 آية، وأحاديثُ الأحكامِ 4500 حديثاً، وهذهِ النصوصُ منها ما يتعلّقُ بالعباداتِ، ومنها ما يتعلّقُ بالتنظيمِ التشريعيّ) (المدخلُ للتشريع، ص 98).
وبرغمِ هذهِ الوفرةِ منَ الأحاديثِ الفقهيّة عندَ الشيعةِ إلّا أنّهم لم يمنعوا أنفسَهم مِن رواياتِ أهلِ السنّةِ إذا لم يكُن عندَهم روايةٌ تخالفُها، كما عملوا بإجماعِهم إذا كانَ كاشفاً كشفاً قطعيّاً عن سنّةِ الرسولِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلم). ومِن هُنا لم يجِد الشيعةُ مُبرّراً للعملِ بالقياسِ والرّأي مع هذهِ الوفرةِ منَ النصوصِ الفقهيّة، أمّا أهلُ السنّةِ فيفتقرونَ لهذهِ الوفرةِ منَ النصوصِ الفقهيّة كما أنّهم يحرمونَ أنفسَهم مِن موروثِ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام) ممّا دفعَهم للعملِ المُبكّرِ بالرأي وإعطاءِ الشرعيّة للقياس.
وقد اعتبرَ أهلُ السنّةِ القياسَ الأصلَ الثالثَ بعدَ القرآنِ والسنّة، وقد استوعبَ هذا الأصلُ معظمَ المساحةِ الفقهيّة عندَ أهلِ السنّة، حتّى أصبحَ التباينُ الفقهيُّ والتعدّدُ المذهبيّ حالةً صحيّةً تحتَ مظلّةِ العملِ بالرّأي، فلا ضيرَ مِن وجودِ مسألةٍ واحدةٍ فيها ستّةُ آراءٍ فقهيّة، واحدٌ بالوجوبِ، والثاني بالجواز، والثالثُ بالحُرمة، وهكذا الاستحبابُ أو الكراهةُ أو الإباحة.
ولكي يحتوي الأصوليّونَ السنّةُ هذهِ الأزمةَ، ادّعوا أنَّ الأحكامَ التي لم يرِد فيها نصٌّ منَ القرآنِ والسنّةِ ليسَ للهِ فيها حكمٌ، وإنّما الفقيهُ هوَ الذي يُفتي فيها بحسبِ ظنّه، بمعنى أنَّ اللهَ فوّضَ الفقهاءَ على إنتاجِ الأحكامِ عملاً بالقياسِ، فأصبحَ الفقيهُ مولّداً للحُكمِ الشرعيّ ومُصيباً فيهِ حتّى وإن تناقضَ معَ غيرِه منَ الفقهاءِ، فالجميعُ مُصيبٌ طالما لم يكُن للهِ حُكمٌ في الواقعةِ، ولذا أطلقَ عليهم (المصوّبة) في قبالِ الشيعةِ الذينَ يقالُ لهم (المُخطّئة)، حيثُ يعتقدُ الشيعةُ إنَّ للهِ أحكاماً في الواقعِ، ومهمّةُ الفقيهِ هيَ البحثُ عن حُكمِ الله، فإمّا أن يصيبَه وإمّا أن يُخطئَه، فليسَ الفقيهُ إلا كاشفاً عن حُكمِ اللهِ الواقعي، وفي حقيقةِ الأمرِ لم يطرحَ التصويبُ في الفقهِ السنّي لأسبابَ علميّة، وإنّما لإيجادِ غطاءٍ للأزمةِ التي أوقعَتهم فيها محدوديّةُ النصوصِ ورفضُهم لإمامةِ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام) فلم يجدوا طريقاً غيرَ إنكارِ حُكمِ الله فيما لا نصَّ فيه، قالَ ابنُ حزم في كتابِه (الإحكامُ في أصولِ الأحكام): (ذهبَت طائفةٌ إلى أنَّ كلَّ مُجتهدٍ مُصيبٌ، وأنَّ كلَّ مُفتٍ مُحقٌّ في فُتياه على تضادّه) (مجلّةُ المُجتهدِ العددُ التاسع). وذكرَ الغزاليُّ في المُستصفى (فالذي ذهبَ إليهِ مُحققو المصوبةِ أنّه ليسَ في الواقعةِ التي لا نصَّ فيها حُكمٌ معيّنٌ يطلبُ بالظنّ، بل الحكمُ يتبعُ الظنَّ وحُكمُ اللهِ تعالى على كلِّ مجتهدٍ ما غلبَ على ظنّه، وهوَ المُختار، وإليهِ ذهبَ القاضي) (المُستصفى ج2، ص 363). وأنا هُنا لستُ بصددِ مُناقشةِ هذا الأمرِ
الواضحِ البطلان، لأنَّ الحُكمَ الواقعيَّ يتبعُ المصالحَ والمفاسدَ الواقعيّتين، ولا يمكنُ أن يتلوّنَ الواقعِ بتلوّنِ النظرِ الظنّي للفقيه.
ومعَ أنَّ الشيعةَ نصّوا على أنَّ العقلَ هوَ الأصلُ الثالثُ بعدَ القرآنِ والسنّة، إلّا أنّهم لم يحتاجوا إليهِ عمليّاً في استنباطِ الأحكامِ الشرعيّة، وكلُّ ما هوَ موجودٌ هو مناقشتُه أصوليّاً في بابِ المُلازماتِ العقلّية، وقد أشارَ الشهيدُ الصدرُ لهذه الحقيقةِ في مقدّمةِ كتابِه الفتاوى الواضحة، حيثُ قال: (ونرى منَ الضروريّ أن نُشيرَ أخيراً بصورةٍ مُوجزةٍ إلى المصادرِ التي اعتمدنا بصورةٍ رئيسيّةٍ في استنباطِ هذهِ الفتاوى الواضحة، وهيَ كما ذكرنا في مُستهلِّ الحديثِ عبارةٌ عن الكتابِ الكريمِ والسنّةِ النبويّة الشريفة بامتدادهِا المُتمثّلِ في سنّةِ الأئمّةِ المعصومينَ مِن أهلِ البيتِ عليهم السّلام باعتبارِهم أحدَ الثقلينِ الذينَ أمرَ النبيُّ (ص) بالتمسّكِ بهما ولم نعتمِد في شيءٍ مِن هذهِ الفتاوى على غيرِ هذينِ المصدرين، أمّا القياسُ والاستحسانُ ونحوهما فلا نرى مسوّغاً شرعيّاً للاعتمادِ عليها تبعاً لأئمّةِ أهلِ البيتِ عليهم السّلام. وأمّا ما يُسمّى بالدليلِ العقليّ الذي اختلفَ المُجتهدونَ والمُحدّثونَ في أنّهُ هل يسوغُ العملُ به أو لا فنحنُ وإن كنّا نؤمنُ بأنّه يسوغُ العملُ به ولكنّا لم نجِد حُكماً واحداً يتوقّفُ إثباتُه على الدليلِ العقلي بهذا المعنى بل كلُّ ما يثبتُ بالدليلِ العقلي فهوَ ثابتٌ في نفسِ الوقتِ بكتابٍ أو سنّةٍ وأمّا ما يُسمّى بالإجماعِ فهوَ ليسَ مصدراً إلى جانبِ الكتابِ والسنّة ولا يُعتمدُ عليهِ إلّا مِن أجلِ كونِه وسيلةَ إثباتٍ للسنّةِ في بعضِ الحالات، وهكذا كانَ المصدرانِ الوحيدانِ هُما الكتابُ والسنّة ونبتهلُ إلى اللهِ تعالى أن يجعلَنا منَ المُتمسّكينَ بهما ومَن استمسكَ بهما (فقد استمسكَ بالعروةِ الوثقى لا انفصامَ لها واللهُ سميعٌ عليم)) (الفتاوى الواضحة، ج1، ص 15). والذي يرجعُ للموسوعاتِ الاستدلاليّة لفقهاءِ الشيعةِ سوفَ يقفُ على حضورِ النصوصِ في كلِّ بحوثِهم الفقهيّة، وفي حالِ عدمِ وجودِ النصِّ في المسألةِ فإنَّ الأئمّةَ مِن أهلِ البيتِ (عليهم السلام) بيّنوا الأصولَ التي يتمُّ الرجوعُ إليها، وتسمّى هذه الأصولُ بالأصولِ العمليّةِ لأنّها تكشفُ عن الموقفِ العمليّ في حالِ لم يكُن في الموضوعِ نصٌّ شرعيٌّ، مثلَ الاستصحابِ، والبراءةِ، والاحتياطِ، وغيرِها.
ويبقى هناكَ حديثٌ عن حُجّيّةِ الأصولِ العمليّةِ ذاتِ المؤدّى الظنّي، وقد بيّنَ الأصوليّونَ الشيعةُ أنَّ حُجّيّةَ تلكَ الأصولِ ليسَ في كشفِها عن الواقعِ وإنّما في نفسِ طريقيّتها المجعولةِ مِن قِبلِ الشارع، فينحصرُ مؤدّاها في المُنجزيّةِ والمعذريّة، ومِن هُنا ينكشفُ لنا لماذا لم يتمَّ اعتمادُ القياسِ كمصدرٍ للأحكامِ الشرعيّةِ عندَ الشيعةِ، وذلكَ للآتي:
الأوّلُ: إنَّ استنباطَ الأحكامِ الشرعيّة يجبُ أن يقومَ على منهجيّاتٍ يحدّدُها الشرعُ بنفسِه، فليسَت كلُّ منهجيّةٍ أبدعَتها العقليّةُ البشريّةُ تكونُ صالحةً في ذلك، وبخاصّةٍ الطرقُ ذاتُ المؤدّى الظنّي، لأنَّ حُجّيّةَ الدّليلِ إمّا أن تكونَ ذاتيّةً، فلا تحتاجُ إلى جعلِ الجاعل، وهيَ تختصُّ بخصوصِ العلمِ الكاشفِ عن الواقعِ، فليسَ بعدَ كشفِه والتعرّفِ عليهِ شيءٌ، فتكونُ الحُجّيّةُ حينئذٍ منَ اللوازمِ العقليّةِ التي لا تنفكُّ عنه.
وإمّا أن تكونَ الحُجّةُ مجعولةً وهيَ التي لا تنهضُ بنفسِها في مقامِ الاحتجاج، بل تحتاجُ إلى مَن يسندُها مِن دليلٍ عقليٍّ أو شرعي، يقولُ السيّدُ محمّد تقي الحكيم: (وهيَ إنّما تتعلّقُ فيما عدا العلمِ بالأماراتِ والأصولِ إحرازيّةٌ أو غيرُ إحرازيّة، أي فيما ثبتَت له الطريقيّةُ الناقصةُ التي لا تكشفُ عن الواقعِ إلّا في حدودٍ ما، أو لم تثبُت لهُ لعدمِ كشفِه عنه) (أصولُ الفقهِ المُقارن ص 32).
ولعدمِ تماميّتِها لكشفِ الواقعِ لا يمكنُ أن تصلحَ طريقاً لمعرفةِ أحكامِ اللهِ إلّا في حالةِ وجودِ سندٍ شرعيٍّ أو دليلٍ عقليٍّ قطعي أمرَ باتّباعِها، يقولُ السيّدُ الحكيم: (ومعَ كونِ الأماراتِ أو الأصولِ لا تملكُ الحُجيّةَ الذاتيّةَ بداهةً، فهيَ مُحتاجةٌ إلى الانتهاءِ إلى ما يملكُها، وليسَ هناكَ غيرُ القطع، بجعلِ الحُجيّةِ لها مِن قِبلِ مَن بيدِه أمرُ وضعِها ورفعِها) (أصولُ الفقهِ المُقارن ص 32). وبهذا نرفعُ اليدَ عن العملِ بأيّ طريقٍ لا يكونُ حُجّةً بذاتِه أو اكتسبَ الحُجيّةَ بدعمِ الدليلِ القطعي بوجوبِ العملِ به، وقد حذّرَ اللهُ سبحانَه منَ العملِ بالظنِّ إلّا ما أذنَ به، قالَ تعالى: ﴿آللهُ أَذِنَ لَكُم أَم عَلَى اللهِ تَفتَرُونَ﴾[36]، وقولُه: ﴿وَلاَ تَقفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾[37] وقولُه: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغنِي مِنَ الحَقِّ شَيئًا﴾[38].
وإذا اتّضحَ ذلكَ يتّضحُ أنَّ مدارَ العملِ بالقياسِ هو العلّةُ المُستنبطةُ منَ الأصلِ، وبالتالي ينحصرُ مسارُ البحثِ في العلّة، ومسالكِ استنباطِها، وبما أنَّ طرقَ كشفِ العلّةِ ظنيّةٌ، لعدمِ توقّفِ القياسِ عادةً على العلّةِ القطعيّة، فلا يصلحُ حينَها أن يكونَ القياسُ طريقاً للحُكمِ الشرعي، إلّا إذا كانَ هناكَ مُستندٌ شرعيٌّ يجوّزُ العملَ به، وقد ثبتَ عدمُ وجودِ هذا المُستندِ في أيّ نصٍّ مِن نصوصِ الشرع، وعندَما لم يجِد الغزاليُّ مفرّاً مِن هذا الإشكالِ عمدَ إلى المُصادرةِ وإطلاقِ مُسلّماتٍ غيرِ مؤسّسةٍ كقولِه (بل لو وضعوا – أي الصّحابةُ - القياسَ واخترعوا استصواباً برأيهم ومِن عندِ أنفسِهم لكانَ ذلكَ حقّاً واجبَ الاتّباع) (المُستصفى ص 253). فإذا ألزمَ الغزاليُّ نفسَه بمثلِ هذا المُستندِ لحُجيّةِ العملِ بالقياس، فنحنُ أيضاً يكفينا الأصلُ القاضي بعدمِ حُجيّةِ القياسِ إذا شككَنا في حُجيّتِه.
الأمرُ الثاني: إنَّ إشكالنا ليسَ على القياسِ الجليّ كقياسِ الأولويّةِ أو كما يُسمّى بمفهومِ الموافقةِ وفحوى الخطاب، كالحُكمِ القاضي بحُرمةِ ضربِ الوالدين لأنّه أولى مِن قولِ أفٍّ لهُما كما قالَ تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ وقد منعَ بعضُهم أن يكونَ هذا نوعاً منَ القياسِ، بل عملاً بالظاهرِ.
وكذلكَ لم يكُن الإشكالُ على القياسِ المنصوصِ العلّةِ كأن يقولَ الشارع: «إنَّ الخمرَ حرامٌ لأنّهُ مُسكِرٌ» فنعرفُ أنَّ علّةَ حُرمةِ الخمرِ الإسكار، فنقيسُ عليها كلَّ سائلٍ مُسكرٍ كالنبيذ، وقد استبعدَ أيضاً مِن كونِه قياساً، لأنّنا لم نقِس النبيذَ على الخمرِ، وإنّما النبيذُ والخمرُ كلاهُما يرجعانِ إلى نصٍّ واحدٍ وهو «كلُّ مُسكرٍ حرام» فلا يُعتبرُ أيُّ واحدٍ منهما الأصلَ والثاني فرع.
فينحصرُ إشكالنا على القياسِ المُستنبطِ العلّة التي يقومُ الفقيهُ بتحصيلِها بالجُهدِ والفكر، ومحتوى الإشكالِ يكمنُ في كونِ العللِ المُستنبطةِ ظنيّة، فلعلَّ الشارعَ لم يرتِّب الحُكمَ على تلكَ العلّةِ المُكتشفةِ، قالَ ابنُ حزم (وإن كانَت العلّةُ غيرَ منصوصٍ عليها فمِن أي طريقٍ تُعرَف ولم يوجَد منَ الشارعِ نصٌّ يبيّنُ طريقَ تُعَرِّفها؟ وتركُ هذا مِن غيرِ دليلٍ يُعرِّفَ العلّةَ ينتهي إلى أحدِ أمرين، إمّا أنَّ القياسَ ليسَ أصلاً مُعتبراً، وإمّا أنّهُ أصلٌ عندَ اللهِ مُعتبرٌ ولكنّهُ أصلٌ لا بيانَ له، وذلكَ يؤدّي إلى التلبيسِ، وتعالى اللهُ عن ذلك َعلوّاً كبيراً، فلم يبقَ إلّا نفيُ القياس) (السُّبحاني، مصادرُ الفقهِ الإسلامي ومنابعُه، ص 211).
ولم يستبعِد الغزاليُّ كونَ هذهِ العلل مظنونةً ولكنَّه برّرَ العملَ بها وِفقاً لرأي المصوّبةِ الذينَ لا يرونَ للواقعِ حُكماً مُستقلاً وإنّما يدورُ مع ظنونِ المُجتهد، فقد ذكرَ في معرضِ ردِّه على الذينَ أشكلوا على القياسِ لكونِه مظنونَ العلّة بقولِه: (واحتمالُ الخطأ إنّما يستقيمُ على مذهبِ مَن يقولُ المُصيبُ واحدٌ وفي موضعٍ يقدرُ أن ينصبَ اللهُ تعالى أدلّةً قاطعةً، يُتصوّرُ أن يحيطَ بها الناظرُ، أمّا مَن قالَ كلُّ مجتهدٍ مُصيبٌ فليسَ في الأصلِ وصفٌ مُعيّنٌ هوَ العلّةُ عندَ اللهِ تعالى حتّى يُخطئ أصلها أو وصفها، بل العلّةُ عندَ اللهِ تعالى في حقِّ كلِّ مجتهدٍ ما ظنَّه علّةً فلا يتصوّرُ الخطأ ولكنّه على الجُملةِ يحتاجُ إلى إقامةِ الدليلِ في هذهِ وإن كانَت أدلّةً ظنيّة) (المُستصفى، ص 280).
وفي المُحصّلةِ أنَّ الفقهَ الشيعيَّ يقومُ على وجودِ وفرةٍ منَ النصوصِ الشرعيّة فلم يجِد ما يدفعُه للعملِ بالرّأي والقياس، أمّا المسائلُ التي لم يرِد فيها نصٌّ فقد بيّنَ الائمّةُ مِن أهلِ البيتِ (عليهم السّلام) الأصولَ والقواعدَ التي يعتمدُ عليها الفقيهُ لبيانِ الموقفِ العمليّ للمُكلّف.
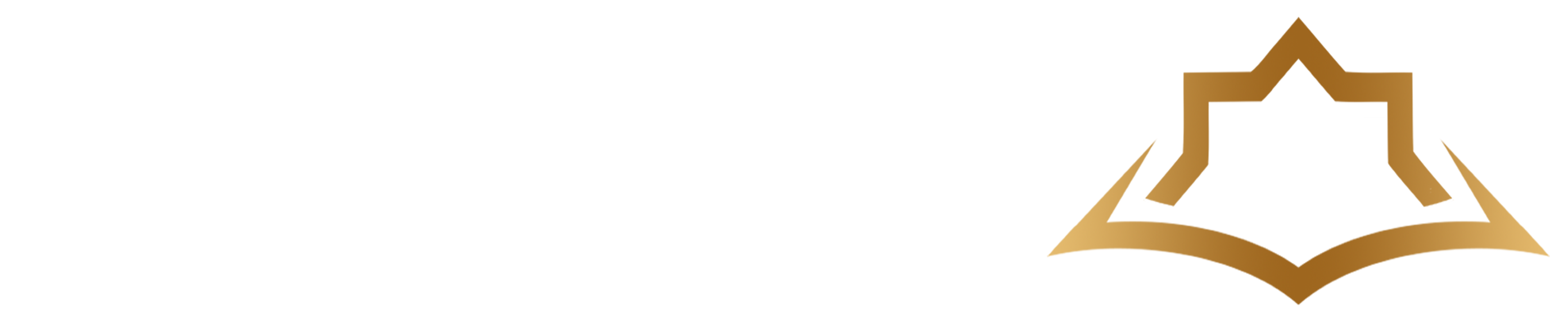

اترك تعليق