هل دُعاءِ الإمامِ السّجّادِ "الحمدلله الذي امرض وشفى " يُعدُّ خروجاً عَن طبيعةِ الأدبِ أم لا؟
رايت من خلال القرآن الكريم ان الانبياء كانو في قمة الادب مع الله سبحانه وتعالى كالخضر عليه السلام في سورة الكهف عندما نسب الخير لله والشر له مع انه كله من امر الله جل جلاله، وابينا ابراهيم عليه السلام قال (واذا مرضت فهو يشفين) ففي هذه العبارة لم ينسب المرض لله وهذه قمة الادب . بينما قرات في ادعية الامام السجاد الذي هو خريج المدرسة المحمدية قوله في دعاء يوم الاثنين: (الحمدلله الذي امرض وشفى) فنسب لله الإمراض! مع اني لااشك بالأئمة صلوات الله عليهم لكني ارغب في معرفة الجواب وشكرا؟
السلام عليكم ورحمة الله
يبدو أنَّ الأمرَ الذي يحتاجُ إلى معالجةٍ هوَ تعريفُ الأدبِ بشكلٍ عام والأدبُ معَ اللهِ بشكلٍ خاص، وهَل ما جاءَ في مثالِ السّائلِ مِن دُعاءِ الإمامِ السّجّادِ يُعدُّ خروجاً عَن طبيعةِ الأدبِ أم لا؟
جاءَ عَن أميرِ المؤمنينَ عليّ (عليه السّلام): نِعمَ قرينُ العقلِ الأدب،ِ وإنَّ صلاحَ العقلِ الأدبِ، وكلُّ شيءٍ يحتاجُ إلى العقلِ، والعقلُ يحتاجُ الأدبَ، ولَن ينجعَ الأدبُ حتّى يُقارنَه العقلُ، والآدابُ تلقيحُ الأفهامِ ونتيجةُ الأذهانِ. وإنَّ الأدبَ صورةُ العقلِ، وإنّه في الإنسانِ كشجرةٍ أصلُها العقلُ، وحسنُ الأدبِ زينةُ العقلِ، ولا أدبَ لمَن لا عقلَ له، وإنَّ الأدبَ والدّينَ نتيجةُ العقلِ، وأفضلُ العقلِ الأدبُ، وآدابُ العلماءِ زيادةٌ في العقلِ، وإنَّ بذوي العقولِ منَ الحاجةِ إلى الأدبِ كما يظمأُ الزّرع ُإلى المطرِ، ومَن زادَ أدبُه على عقلِه، كانَ كالرّاعي بينَ غنمٍ كثيرةٍ.
ويقولُ الإمامُ الصّادقُ (عليه السّلام): (إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أدّبَ نبيّهُ فأحسنَ أدبَه، فلمّـا أكملَ لهُ الأدبَ قالَ: (وَإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيم)، ثمّ فوّضَ إليهِ أمرَ النّاسِ والاُمّةِ ليسوس َعبادَه).
وقالَ النّبيُّ الأعظمُ: (أدّبني ربّي فأحسنَ تأديبي). وقالَ: (أنا أديبُ اللهِ، وعليّ أديبي). وقالَ أميرُ المؤمنينَ عليّ (عليه السّلام): (إنَّ رسولَ الله (صلّى اللهُ عليهِ وآله) أدّبهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، وهوَ أدّبني، وأنا أؤدّبُ المؤمنينَ، واُورّثُ الأدبَ المُكرّمينَ).
ويتّضحُ مِن هذهِ الرّواياتِ وغيرِها أنَّ الأدبَ مِن أعظمِ ما يتحلّى بهِ الإنسانُ سواءٌ في تعاملِه معَ الآخرينَ أو في تعاملِه معَ اللهِ؛ لكونِ الأدبِ يُمثّلُ المظهرَ الحسنَ لهيئةِ الإنسانِ في جميعِ أفعالِه الإختياريّةِ، ولِذا جاءَتِ الأوامرُ الشّرعيّةُ بضرورةِ تزكيةِ النّفسِ وتهذيبِها؛ لأنَّ التّحليّ بالقيمِ والتّخلّق بالفضائلِ هوَ الذي يُوفّرُ الهيئةَ الحسنةَ لأفعالِ الإنسانِ، وقَد قرنَت الرّواياتُ بينَ الأدبِ والعقلِ، وعليهِ لا يمكنُ أن نفهمَ الأدبَ إلّا في إطارِ العقلِ، ولا يظهرُ حُسنُ العقلِ إلّا مِن خلالِ الأدبِ؛ فالتّعقّلُ في منطقِ القُرآنِ يعني إلتزامَ الإنسانِ في كُلِّ تصرّفاتِه بما يُمليهِ عليهِ العقلُ، ولا يكونُ ذلكَ إلّا بمُخالفةِ النّفسِ وتجنُّبِ الهوى والشّهواتِ والرّغباتِ المادّيّةِ، وعليهِ فإنَّ الميزانَ في معرفةِ ما كانَ الفعلُ مُناسِباً للأدبِ أو غيرَ مُناسبٍ هوَ مدى بُعدِ الفعلِ وقُربِه منَ القيمِ والفضائلِ مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ أُخرى مدى مُناسبةِ هذا الفعلِ للموضوعِ الخارجيّ بحسبِ ما يحكمُ بهِ العقلُ ويمليهِ تصرّفُ العقلاءِ، فقد يكونُ الفعلُ مُتناسباً معَ القيمِ والفضائلِ إلّا أنّهُ غيرُ مُتناسبٍ معَ الموضوعِ الخارجيّ، فمثلاً الرّحمةُ منَ القيمِ الأخلاقيّةِ التي يجبُ أن يلتزمَ بها الإنسانُ في أفعالِه، ولكِن ليسَ كلُّ المواطنِ تتناسبُ معها الرّحمةُ، فالرّحمةُ بالقاتلِ مثلاً غيرُ مُناسبةٍ، فمعَ أنّها قريبةٌ منَ القيمِ إلّا أنّها في هذا المثالِ بعيدةٌ عن مُناسبةِ الواقعِ، وكذلكَ الحالُ في التّواضعِ كقيمةٍ أخلاقيّةٍ تكشفُ عَن مُستوىً رفيعٍ منَ الأدبِ، إلّا أنّهُ لا يكونُ في كلِّ الأحوالِ والظّروفِ مطلوباً، فالتّواضعُ للغنيّ لغناهُ أو للمُتكبّرِ غيرُ مُناسبٍ حتّى وإن كانَ التّواضعُ في نفسِه منَ الآدابِ، وبالتّالي تُفهمُ الآدابُ دائِماً في إطارِ العقلِ ومُنطلَقِ الواقعِ، ومِن جهةٍ أخرى نجدُ أنَّ الآدابَ هيَ التي تُزيّنُ العقلَ وتُظهرُه في أجملِ صورِه، فمثلاً إذا حكمَ العقلُ بأنَّ فُلاناً منَ النّاسِ إرتكبَ خطأً وعليهِ يجبُ مُصارحتُه ونصحُه، هُنا نجدُ أنَّ الآدابَ تتدخّلُ لتُقدّمَ ذلكَ النُّصحَ بصورةٍ جميلةٍ لا تجرحُ كرامتَه وتجعلَه سعيداً حتّى هوَ في حالِ إعترافِه بالخطأِ. وبناءً على ذلكَ إذا وقفنا على الأمثلةِ التي ذكرَها السّائلُ، سنجدُ كلَّ فعلٍ منها مثّلَ الأدبَ بما يتناسبُ معَ الواقعِ، فقولُ نبيّ اللهِ الخضرِ (أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَت لِمَسَٰكِينَ يَعمَلُونَ فِى البَحرِ فَأَرَدتُّ أَن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصبًا) حيثُ نسبَ فعلَ تخريبِ السّفينةِ إلى نفسِه، ولم ينسبها إلى اللهِ الذي أمرَهُ بذلكَ، وهذا طبيعيٌّ بحسبِ مُناسبةِ الموضوعِ، فاعتراضُ موسى كانَ مُتوجّهاً لِما فعلَهُ العبدُ الصّالحُ وهوَ قولُه (قَالَ أَخَرَقتَهَا لِتُغرِقَ أَهلَهَا لَقَد جِئتَ شَئًا إمرًا) فالفعلُ كانَ في نظرِ موسى قبيحاً ولذلكَ إعترضَ على العبدِ الصّالحِ، وعليهِ لابُدَّ أن تكونَ الإجابةُ على نفسِ الفعلِ الذي وقعَ عليه الإعتراضُ، وبما أنَّ الفاعلَ المُباشرَ كانَ العبدَ الصّالحَ فمنَ الضّروريّ أن يكونَ الرّدُّ (فَأَرَدتُّ أَن أَعِيبَهَا )، أمّا عندَما تحوّلَ الكلامُ إلى الغايةِ والقصدِ مِن وراءِ هذا الفعلِ كانَ منَ الطّبيعيّ أيضاً أن ينسبَ ذلكَ إلى اللهِ بوصفِه المُدبّرَ والمُخطّطَ لذلِك.
أمّا قولُ إبراهيمَ (عليه السّلام) (وَإِذَا مَرِضتُ فَهُوَ يَشفِينِ) فواضحٌ مِن خلالِ سياقِ الآياتِ، أنَّ إبراهيمَ (عليه السّلام) كانَ في معرضِ تمجيدِ ربّه وإظهارِ فضلِه أمامَ مَن يعتقدُ بالأصنامِ، فهَل منَ المنطقِ أن يقولَ لهُم إنَّ ربّي هوَ الذي يُمرضُ؟ فمنَ الحكمةِ والمنطقِ أن لا يتحدّثَ معهُم أنَّ المرضَ الذي يصيبُهم منَ اللهِ، وإنّما يتحدّثُ عَن وقوعِ المرضِ بوصفِه حالةً تُصيبُ الجميعَ ولِذا قالَ (إذا مرضتُ) كما يمرضُ الآخرونَ فإنَّ اللهَ هوَ الشّافي لذلكَ المرضِ، وهذا بخلافِ دُعاءِ الإمامِ السّجّادِ (عليه السّلام) الذي هوَ في مقامِ الإعترافِ للهِ بما له مِن قُدرةٍ وسُلطانٍ، ومنَ الواضحِ أنَّ إظهارَ العبوديّةِ والإنقطاعَ التّامَّ للهِ يقتضي الإعترافَ للهِ بكونِه مالكَ كلِّ شيءٍ ولا مالكَ سواهُ، فمنَ الطّبيعيّ أن يقولَ (هوَ الذي أمرضَ وشفى) لأنَّ ليسَ لغيرِه سُلطةٌ على هذا الوجودِ، وعليهِ قمّةُ الإعترافِ لصاحبِ الحقِّ هيَ قمّةُ الأدبِ في محضرِه.
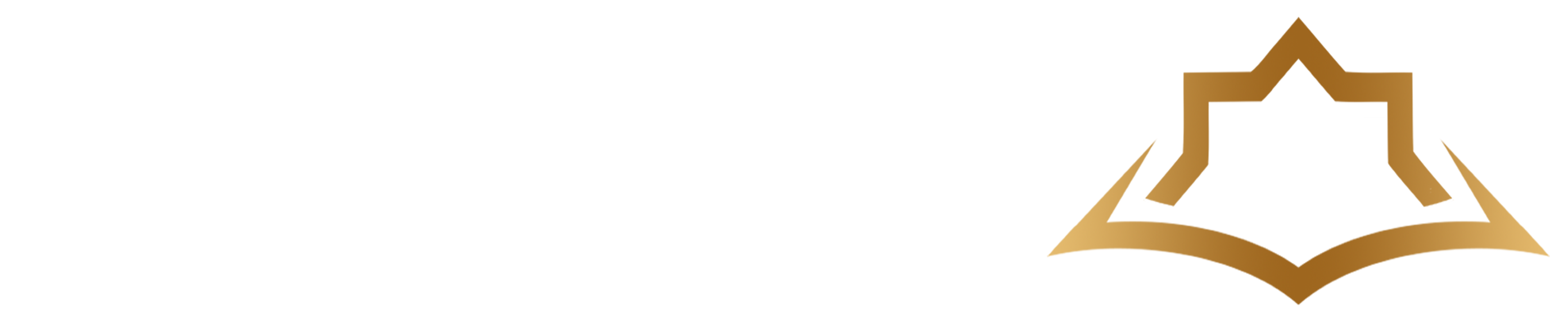

اترك تعليق