من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فإنها لم تخن أباه
السلام عليكم "الصادق عليه السلام يقول لأصحابه: من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فإنها لم تخن أباه (1). وكان الصبي على عهد رسول الله اذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية امير المؤمنين فان قبلها الحق نسبه بمن ينتمي اليه وان انكرها نفي" ممكن شرح لهذه الرواية وماذا يقصد الإمام ..وهل كل ابن حرام يولد غير محب لمحمد وآل محمد .. وما ذنبه في ذلك
من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فإنها لم تخن أباه ;ماذا يقصد الإمام الصادق ؟وهل كل ابن حرام يولد غير محب لال محمد؟ وما ذنبه في ذلك؟
لفهمِ مثلِ هذهِ الرّواياتِ لابُدَّ منَ الإنطلاقِ منَ المُحكماتِ وهيَ المُسلّماتُ العقليّةُ والدّينيّةُ، بوصفِها القواعدَ التي نُرجعُ إليها فهمَ المُتشابهاتِ، والمسلّمُ بهِ فيما يخصُّ ابنَ الزّنا وعلاقتَه بأهلِ البيتِ (عليهم السّلام)، هوَ كونُ الإنسانِ حرّاً في تحديدِ مصيرِه ولا يتحرّكُ في الحياةِ على أساسِ الجبرِ ومصادرةِ إرادتِه الشّخصيّةِ، وعليهِ ما لا ينسجمُ معَ بديهيّاتِ الدّينِ والعقلِ هوَ أن يكونَ إبنُ الزّنا منزوعَ الإرادةِ فيما يخصُّ محبّةَ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام)، بَل يمتلكُ كاملَ الحُرّيّةِ في أن يُحبّهُم أو يُبغضَهم، وعليهِ لا تُفهمُ الرّواياتُ على أساسِ الحتميّةِ الجبريّةِ وإنّما على أساسِ المُقتضى الذي يُؤثّرُ على قراراتِ الإنسانِ ويجعلُه في العادةِ يبتعدُ عنِ الحقّ، ولفهمِ ذلكَ لابدَّ مِن توضيحٍ عامّ للمؤثّراتِ الخارجيّةِ التي تُؤثّرُ بشكلٍ مُباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ على خياراتِ الإنسانِ.
إنَّ التّباينَ الملحوظَ بينَ شخصيّاتِ البشرِ هوَ الذي يقفُ خلفَ التّباينِ بينَ خياراتِهم في شتّى حقولِ الحياةِ، فشخصيّةُ كلِّ إنسانٍ تُشكّلُ وسيطاً بينَه وبينَ الحقائقِ الخارجةِ، وهوَ وسيطٌ غيرُ أمينٍ في نقلِ الخارجِ، فكلُّ إنسانٍ يحاولُ أن يُصوّرُ الواقعَ بشكلٍ ينسجمُ معَ شخصيّتِه، فلا ينظرُ إلى الحقائقِ كما هيَ وإنّما ينظرُ إليها كما يحبُ أن يراها، ومِن جانبٍ آخرٍ نرى مجموعةً منَ العواملِ المُتداخلةِ هيَ التي تساهمُ في بناءِ شخصيّةِ الإنسانِ، فبدءاً منَ الجيناتِ الوراثيّةِ التي تُؤثّرُ في بناءِ الشّخصيّةِ، ومروراً بالأسرةِ التي يقومُ فيها الوالدانُ بتطبيعِ المولودِ وتربيتِه بما يتوافقُ ووعيَهُم الثّقافيّ، وانتهاءً بالمُحيطِ الإجتماعيّ والسّياسيّ والإقتصاديّ، والبيئةِ الجُغرافيّةِ وغيرِها، كلُّها عواملُ تساهمُ في بناءِ شخصيّة الإنسانِ، ومِن هُنا نجدُ التّمايزَ في طبائعِ النّاسِ وشخصيّاتِهم، فكلُّ واحدٍ يحملُ شخصيّةً عملَت كثيرٌ منَ الظّروفِ الخاصّةِ على صياغتِها وتشكيلِها، وكلُّها- كما هوَ واضحٌ- عواملُ لا يساهمُ الإنسانُ في اختيارِها ولا يصنعُها بمحضِ إرادتِه، وهذا التّمايزُ في الطّبائعِ والشّخصيّاتِ هوَ السّببُ المباشرُ للتّباينِ في المواقفِ وتقييمِ الأفكارِ والأحداثِ، فالإنسانُ يبني علاقاتِه بالأشياءِ بناءً على تقييمِه لها، وهذا التّقييمُ ليسَ عمليّةً عقليّةً مُجرّدةّ، وإنّما تساهمُ فيهِ شخصيّةُ الإنسانِ ونفسيّتِه في الدّرجةِ الأولى.
ولكَي تتّضحَ الفكرةُ، فإنّنا نحاولُ تبسيطَها بأمثلةٍ حولَ تباينِ النّاسِ في بعضِ الأمورِ الحياتيّةِ؛ مِن نوعِ الأكلِ والشّربِ، وما يتعلّقُ بالذّوقِ العامّ، مِن نوعِ اللّبسِ والمسكنِ وغيرِها، رغمَ أنَّ هذا النّوعَ منَ التّباينِ لا يُشكّلُ مُشكلةً، بعكسِ التّباينِ في تقييمِ المواقفِ والأفكارِ والأحداثِ الكُبرى، ولكنّه يؤكّدُ إلى أيّ درجةٍ يمكنُ أن يكونَ الإنسانُ مُحاطاً بأشياءَ تؤثّرُ في مواقفِه وقناعاتِه، فالعاداتُ والتّقاليدُ التي تُميّزُ التّجمّعاتِ البشريّة، تُشكِّلُ الحاضنَ والبيئةَ التي يتكيّفُ معها المولودُ منذُ ولادتِه، مثل نوعِ الأكلِ واللّبسِ والمسكنِ، فالإنسانُ العربيُّ مثلاً، لا يأكلُ ما يأكلُه الإنسانُ الصّينيّ بَل قد يستقذرُه، في حينِ أنَّ هذا الإنسانَ نفسَه، لو تربّى في الصّينِ وعاشَ فيها، نجدُه يشتهي هذهِ الأكلاتِ ويُحبُّها، رغَم أنَّ الشّخصَ هوَ الشّخصُ، والأكلَ هوَ ذاتُه الأكلُ لم يتغيّر، ولكنَّ الذي تغيّرَ هو نفسيّتُه وشخصيّتُه، وهكذا تختلفُ شخصيّةُ الإنسانِ إذا نشأ مثلاً في مُجتمعاتٍ مُترفةٍ عَن شخصيّةِ الآخرِ الذي نشأ في مُجتمعٍ فقيرٍ، أو الذي نشأ في مُجتمعٍ ديمقراطيٍّ تعدّديّ، يختلفُ عنِ الذي نشأ في مجتمعٍ مغلقٍ ونظامٍ دكتاتوريٍّ قمعيّ، وهكذا تتداخلُ العواملُ وتتعدّدُ، لتُشكّلَ حضورَها في تحديدِ مساراتِ الإنسانِ وخياراتِه، وعليهِ فإنَّ تقييمَ الواقعِ والتّفاعلَ معه، لا يرتكزُ على شروطٍ موضوعيّةٍ تلاحظُ الواقعَ بما هو كائنٌ، وإنّما كيفَ يكونُ هذا الواقعُ بالنّسبةِ للإنسانِ وكيفَ يراه.
وإذا فهمنا هذا نفهمُ الأسسَ التي تُبنى عليها خياراتُ الإنسانِ في العادةِ والعواملِ المؤثّرةِ على هذهِ الخياراتِ، والرّواياتُ التي تُشيرُ إلى ابنِ الزّنا وبخاصّةٍ في عدمِ محبّتِه لأهلِ البيتِ (عليهم السّلام) أو نفورِه منَ الحقّ بشكلٍ عامّ، تؤكّدُ على تأثيرِ النّطفةِ المُنعقدةِ منَ الحرامِ على نفسيّتِه وبالتّالي على قرارتِه، مُضافاً للشّعورِ بالنّقصِ والدّونيّةِ وفقدانِه للبيئةِ غيرِ السّليمةٍ للتّنشئةِ وحرمانِه مِن حنانِ الأسرةِ ومُضايقةِ المُجتمعِ له، كلُّ ذلكَ يُؤثّرُ بشكلٍ واضحٍ على نفسيّتِه، ومعَ أنَّ إبنَ الزّنا ليسَ مسؤولاً عَن عمليّةِ الزّنا إلّا أنَّ عدمَ مسؤوليّتِه لا يعصمُه مِن هذهِ الآثارِ، وعليهِ فإنَّ إبنَ الزّنا مُرشّحٌ ومُهيّأٌ على أن تكونَ نفسيّتُه أكثرَ تعقيداً وخُبثاً، ومنَ الطّبيعيّ جدّاً أن تنفُرَ النّفوسُ الخبيثةُ منَ النّفوسِ الطّاهرةِ، وهذا ما أكّدتهُ الرّواياتُ بأنَّ الذي يجدُ بردَ محبّةِ أهلِ البيت (عليهم السّلام) في قلبِه فهو دليلٌ على صفاءِ سريرتِه منَ الخُبثِ، وهذا غيرُ موقوفٍ على إبنِ الزّنا فليسَ كلُّ خبيثِ النّفسِ ابنَ زنا، وقد خصَّت الرّوايةُ ابنَ الزّنا بالذّكر.ِ لسببين، الأوّلُ: لكونِه المُهيّأَ أكثرَ لخُبثِ النّفسِ، والثّاني: إبنُ الزّنا وصفٌ ينفرُ منهُ الجميعُ، وبالتّالي تكونُ الرّوايةُ عالجت ظاهرتين بعبارةٍ واحدةٍ، ظاهرةُ البُغضِ لأهلِ البيتِ (عليهم السّلام) وظاهرةُ الزّنا وما ينتجُ عنها مِن مفاسدَ إجتماعيّةٍ.
والملحوظةُ التي يجبُ الإشارةُ إليها أنَّ كلَّ هذهِ العواملَ التي تتدخّلُ في خياراتِ الإنسانِ المُستقبليّةِ ليسَت حتميّةً وإنّما يمتلكُ الإنسانُ دوماً الحُرّيّةَ في مواجهتِها، فلا الإستسلامُ لهذهِ العواملِ، ولا التّنكّرُ لها وعدمُ الإعترافِ بها يُمثّلُ خياراً صحيحاً، فالإستسلامُ يعني الجبرَ ومُصادرةَ الحُرّيّةِ، والتّنكّرُ لا يمنعُ مِن تأثيرِها الخفيّ على قراراتِ الإنسانِ، وهذا خلافُ بعضِ النّظريّاتِ والفلسفاتِ التي سوّقَت لهَا بوصفِها حتميّاتٍ لابُدَّ منها، مثلَ الحتميّةِ التّاريخيّةِ، والحتميّةِ الإجتماعيّةِ، والحتميّةِ المادّيّةِ، والحتميّةِ الإقتصاديّةِ، وغيرِها مِن حتميّاتٍ تتلاشى معها إرادةُ الإنسانِ في التّغييرِ، فنحنُ نُسلّمُ بتأثيرِ كُلِّ تلكَ العواملِ، بما فيها إنعقادُ النّطفةِ منَ الحرامِ، ولكِن لا نؤمنُ بالحتميّةِ، فبإمكانِ الإنسانِ أن يُساهمَ بمحضِ إرادتِه في إعادةِ بناءِ شخصيّتِه.
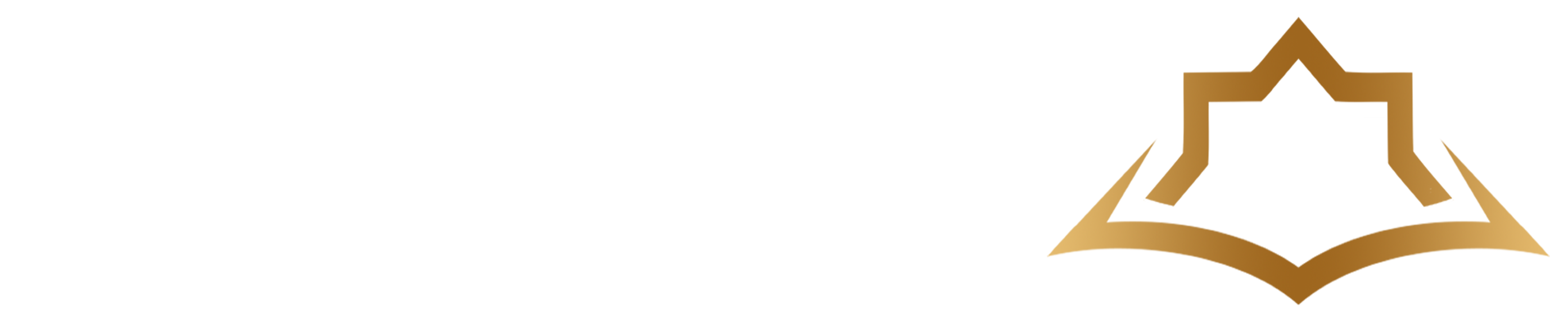

اترك تعليق