ما هو معيار الله في حب أو كره المجتمعات؟
ما هو معيار الله في حب أو كره المجتمعات؟ هل هو الفقر أم الغنى أم التطور التقني أم العسكري أم ماذا؟ (مقال عن العودة إلى الأديان السماوية في زمن تسابق المجتمعات والدول على النماء الاقتصادي والتسليح ظناً منهم أن كمال المجتمعات ورفاهها في التركيز على المادة دون الروح والأخلاق)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : معَ الأسفِ لم نفهَم مقصودَ السائلِ حتّى تكونَ أجابتُنا على النحوِ الذي يريدُه، ولذا سوفَ تتوقّفُ الإجابةُ على ما يظهرُ منَ السؤال، فصيغةُ السؤالِ قد تُحمَلُ على مَعنيين، الأوّلُ: ما هوَ المعيارُ الذي على أساسِه يحبُّ اللهُ بعضَ المُجتمعاتِ ويكرهُ أخرى؟ وحينَها يكونُ الحبُّ والكرهُ مُتعلّقاً باللهِ تعالى. والثاني: ما هوَ المعيارُ الإلهيُّ الذي على أساسِه نحبُّ نحنُ المُكلّفونَ بعضَ المُجتمعاتِ ونكرهُ أخرى؟ فيكونُ الحبُّ والكُره مُتعلّقاً بالمُكلّف. وقبلَ أن نُجيبَ بشكلٍ مُباشرٍ على تلكَ الأسئلة، لابدَّ مِن بيانِ الجوّ الثقافيّ الذي يُشكّلُ خلفيّةً لكثيرٍ منَ الأسئلةِ الإشكاليّة، فليسَ منَ المُستبعدِ أن تكونَ خلفيّةُ هذا السؤالِ أيضاً قائمةً على الاعتزازِ بثقافةِ العصرِ الماديّة في مقابلِ الثقافةِ الدينيّة. فعندَما تتحدّثُ الثقافةُ المُعاصرةُ عن الإنسانِ إنّما تتحدّثُ عن الإنسانِ الطبيعيّ ذو البُعدِ الواحدِ وهوَ البُعدُ الماديّ، والإنسانُ ضمنَ هذا الوصفِ مُكتفٍ بذاتِه حيثُ يُشكّلُ مِن نفسِه المرجعَ والمعيارَ لكلِّ شيءٍ، وبالتالي ليسَ أمامَه أيّة حدودٍ أو قيودٍ تاريخيّةٍ أو اجتماعيّةٍ أو أخلاقيّةٍ أو ثقافيّة فهوَ يعيشُ في الزمانِ الطبيعيّ ولا يعيشُ في الزمانِ الإنسانيّ الذي تحكمُه القيمُ والأخلاقيّات، فكلُّ شيءٍ يتمُّ تفسيرُه بحسبِ المادّةِ حتّى أحاسيسُه ومشاعرُه ورغباتُه ليسَت إلّا نتاجَ الطبيعةِ المُتأصّلةِ فيه، والعقلُ ضمنَ هذا التصوّرِ فاقدٌ للسُّلطةِ وخاضعٌ بشكلٍ دائمٍ لميولاتِ النفسِ ورغباتِها، وحينَها لا يحقُّ للعقلِ الارتقاءُ بالإنسانِ معنويّاً وروحيّاً مِن خلالِ البحثِ عن المعنى والمُقدّس؛ لأنَّ كلَّ ذلكَ يمنعُ الإنسانَ منَ الذوبانِ التامِّ في جانبِه الطبيعيّ والمادّي، وحتّى لو تمَّ الحديثُ عن القيمِ الأخلاقيّة فلا يتعدّى الحديثُ الدوافعَ الطبيعيّةَ القائمةَ على الأنانيّةِ والحرصِ على البقاءِ والمنفعة، ولذا يتمُّ التوافقُ على بعضِ النظمِ والقوانينِ التي تحفظُ البقاءَ الماديَّ للإنسان، وهكذا فالإنسانُ في هذه الثقافةِ هو جزءٌ لا يتجزّأ منَ الطبيعة، بخلافِ النظرةِ الدينيّةِ التي تجعلُ الإنسانَ جُزءاً يتجزّأ منَ الطبيعة، فلو استحالَ على الإنسانِ مُفارقةُ الطبيعةِ مِن خلالِ بُعدِه الروحيّ والمعنوي، فحينَها سيكونُ مُتبدّلاً ومتحوّلاً مثلَ الطبيعةِ والمادّة، وبذلكَ تنعدمُ الثوابتُ وتتلاشى المُشتركاتُ الإنسانيّةُ على المُستوى المعرفيّ والأخلاقي، ولذلكَ نجدُ العلومَ الإنسانيّةَ الغربيّةَ تتعاملُ مع الإنسانِ بوصفِه وظائفَ بيولوجيّةً وماديّةً، فهوَ مُجرّدُ نظامٍ طبيعيّ كغيرِه يخضعُ للحتميّةِ الماديّة.. وعليهِ لم تُنتِج لنا الثقافةُ الحديثةُ إلّا نوعينِ منَ البشر، الأوّلُ: هوَ الإنسانُ الاقتصاديّ وهوَ إنسانُ آدم سميث الذي تحرّكُه الدوافعُ الاقتصاديّةُ والنفعيّة والسعيُ لتراكمِ الثروةِ والرّبح، أو إنسانُ ماركس المحكومُ بعلاقاتِ الإنتاجِ وهوَ إنسانٌ مُنفصلٌ تماماً عن القيمةِ ولا تحرّكُه إلّا الدوافعُ الاقتصاديّة، والثاني: هوَ الإنسانُ الجسمانيُّ الشهواني وهوَ إنسانُ فرويد الذي تحرّكُه دوافعُه الشهوانيّةُ حيثُ تتلخّصُ حياتُه في البحثِ عن اللذّةِ الغرائزيّة، فهوَ إنسانٌ استهلاكيٌّ يعيشُ البذخَ والترف، وهوَ أيضاً إنسانٌ مُتجرّدٌ عن القيمِ والأخلاق، وما يؤسفُ له أنَّ الإنسانَ المُعاصرَ هوَ خليطٌ بينَ الإنسانينِ اقتصاديٌّ ماديٌّ وشهوانيٌّ غرائزيّ ، وتمَّ في المقابلِ استبعادُ الروِح وما تحملهُ مِن قيمٍ وأخلاق. ونحنُ هُنا لا نتنكّرُ على ما أنجزَته الحداثةُ مِن أمورٍ مُفيدةٍ مثلَ التقدّمِ العلميّ والتكنلوجيّ والاقتصاديّ، مُضافاً لبعضِ الشعاراتِ مثلَ الحريّاتِ والتسامحِ والحقوق.. وقد عبّرنا عنها بالشعاراتِ لأنَّ هناكَ تناقضاً واضحاً بينَ مضامينِ تلكَ الكلماتِ وبينَ الواقعِ الذي نعيشُه، فمثلاً ثقافةُ التسامحِ نجدُها في التوسّعِ والاستعمارِ ومُحاربةِ الأفكارِ المُغايرة، وثقافةُ التقدّمِ والتطوّرِ نجدُها تقومُ على استغلالِ الشعوبِ وإفقارِها، وهكذا تتمُّ التنميةُ والتطوّرُ لأيّ مُجتمعٍ على حسابِ تجهيلِ وتخلّفِ مُجتمعٍ آخر، وبالتالي قيمُ الحداثةِ لا تكونُ مُفيدةً إلّا في ظلِّ فلسفةٍ أخلاقيّةٍ تعترفُ بالجانبِ الروحي في الإنسان، ومِن هُنا نحنُ لا نرفضُ الكثيرَ منَ الأفكارِ التي تنادي بها الحداثةُ ولكن نرفضُ أن تكونَ أفكاراً ماديّةً تُهملُ الجانبَ الروحيَّ والأخلاقيَّ في الإنسان، فمثلاً الحريّةُ التي تجعلُ المرأةَ سلعةً تُباعُ وتُشترى، أو الحريّةُ التي تحطّمُ إنسانيّةَ الإنسانِ لا يمكنُ قبولُها، لكونِها قائمةً فقط على جانبِ الجسدِ دونَ الرّوح.وعليهِ فإنَّ حقيقةَ الإنسانِ ضمنَ الإيمانِ بالله ترتكزُ على علاقةِ المخلوقِ بالخالق، أي أنَّ الإنسانَ أوجدَه الله مِن عدمٍ وخلقَه على الهيئةِ التي هوَ عليها، قبضةً مِن طين، ونفخةً مِن روح، فانتمى إلى الأرضِ مِن جهةِ الطينةِ، وانتمى إلى السماءِ مِن جهةِ تلكَ النفخة، وبالتالي بإمكانِ الإنسانِ العيشُ على الأرضِ وهو يتطلّعُ إلى الله، وبهذا لا يحكمُ الإنسانَ ميولٌ أو اتّجاهٌ واحد، وإنّما ينجذبُ إلى الأرضِ كما يندفعُ إلى الأعلى ليتسامى على المادّة.وبذلكَ يعترفُ المؤمنُ بالمادّةِ فيندفعُ في رحابِ الحياةِ اندفاعَ المؤمنِ بضرورةِ تسخيرِ المادّةِ مِن أجلِ الإنسان، فلا يفوتُه شيءٌ مِن خيراتِ الدّنيا وبهارجِ الحياة، وفي الوقتِ نفسِه يمتازُ عن بقيّةِ الكائناتِ بمقدرتِه على التكاملِ المعنويّ والروحي مِن خلالِ اتّصالِه باللهِ تعالى. الإجابةُ على السؤالِ بشكلٍ مُباشر: والإجابةُ على السؤالِ بحسبِ المعنى الأول تكونُ كالتالي: لم نجِد في القرآنِ آيةً واحدةً تدلُّ على أنَّ اللهَ يحبُّ قوماً لفقرِهم أو لغناهم أو لتطورّهم، وإنّما وضعَت الآياتُ معاييرَ أخرى وهيَ كثيرةٌ مِنها، الإحسانُ في قولِه تعالى: (وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ۛ وَأَحسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحسِنِينَ)، ومِنها التقوى في قولِه تعالى: (بَلَىٰ مَن أَوفَىٰ بِعَهدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ)، ومنها الصبرُ في قولِه تعالى: (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا استَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)، ومنها التوكّلُ في قولِه تعالى: ( فَبِمَا رَحمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم ۖ وَلَو كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلبِ لَانفَضُّوا مِن حَولِكَ ۖ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ ۖ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ)، ومِنها المُقسطونَ في قولِه تعالى: (.. فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا بِالعَدلِ وَأَقسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ)، ومنها المُطهّرونَ في قولِه تعالى: (.. لَّمَسجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقوَىٰ مِن أَوَّلِ يَومٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ) أمّا ما لا يحبّهُ اللهُ بحسبِ الآياتِ فهوَ كثيرٌ أيضاً فمِنها، المُعتدونَ في قولِه تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَلَا تَعتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعتَدِينَ)، ومِنها الفسادُ في قولِه تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَا وَيُهلِكَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ)، ومِنها الكفّارُ في قولِه تعالى: (يَمحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) وكذلكَ قولهُ تعالى: (قُل أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الكَافِرِينَ)، ومِنها الظالمونَ في قولِه تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِم أُجُورَهُم ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)، وهكذا لا يحبُّ المُختالَ الفخور، ولا يحبُّ الخوّانَ الأثيم، ولا يحبُّ المُعتدين، ولا يحبُّ الخائنين، ولا يحبُّ المُستكبرين.. ومنَ الواضحِ ليسَ مِن بينِها المعاييرُ التي سألَ عنهُ السائل. أمّا الإجابةُ على السؤالِ بالمعنى الثاني، كذلكَ لم يأمُرنا اللهُ بحبِّ أو كُرهِ المُجتمعاتِ الأخرى على أساسِ الفقرِ أو الغِنى أو التطوّر، وإنّما جعلَ التقوى هيَ معيارَ التفاضلِ الحقيقيّ بينَ الشعوبِ والمُجتمعات، قالَ تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقَاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، كما نهى القرآنُ عن السُّخريةِ منَ المُجتمعاتِ الأخرى وحرّمَ كلَّ النعراتِ التي تسبّبُ الفُرقةَ والاختلاف، قالَ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسخَر قَومٌ مِّن قَومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيرًا مِّنهُم وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيرًا مِّنهُنَّ ۖ وَلَا تَلمِزُوا أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلقَابِ ۖ بِئسَ الِاسمُ الفُسُوقُ بَعدَ الإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّم يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، كما نهى القرآنُ عن موالاةِ كلِّ مَن غضبَ اللهُ عليهِ في قولِه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوا قَومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِم قَد يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الكُفَّارُ مِن أَصحَابِ القُبُورِ) وبذلكَ يكونُ المعيارُ الذي وضعَه اللهُ في علاقاتِنا معَ المُجتمعاتِ الأخرى هو معيارُ ما يُرضي اللهَ تعالى، ولم يجعَل ذلكَ سبباً للحبِّ والكُره وإنّما جعلهُ سبباً للولاءِ والبراء. ولا يعني هذا أنَّ القرآنَ ضدُّ التقدّمِ والتطوّرِ أو أنّه معَ الفقرِ والتخلّف، بل على العكسِ مِن ذلكَ حيثُ أمرَ بالعلمِ والعملِ ودعاءِ الإنسانِ إلى إعمارِ الأرضِ، وفي نفسِ الوقتِ أمرَه بنُصرةِ المُجتمعاتِ المُستضعفةِ والمَظلومةِ والمحرومة ولم يأمُرهم بكراهيتِهم.
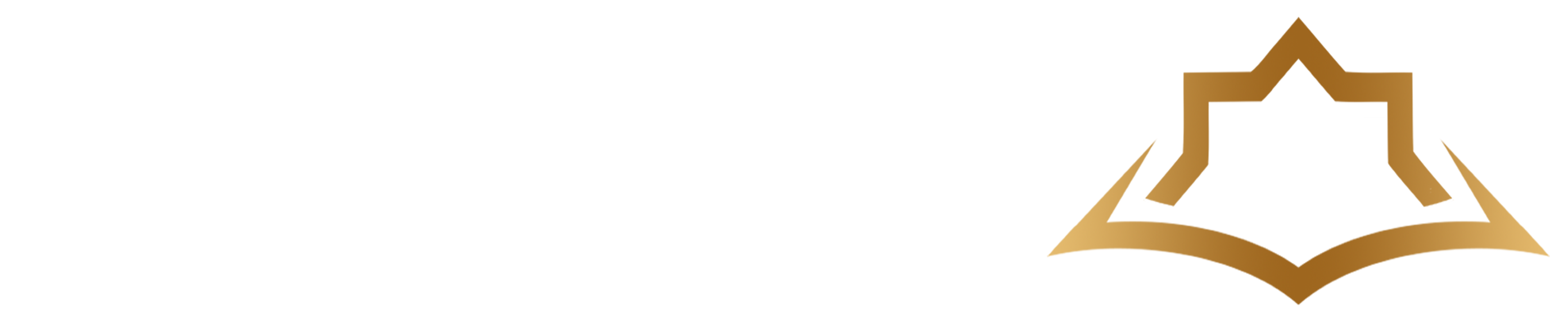

اترك تعليق