هل يمكنُ التوفيقُ بينَ العلمانيّةِ والإسلام؟
لا يقتنع الإسلاميون بنظرة بعض العلمانيين التوفيقية التي تقول بان العلمانية هي فصل الدين عن الدولة ويبقى الدين اختياراً محترماً للإنسان لا يلام على الايمان به، ولا يمنع من ممارسة طقوسه، ولا يطارد معتنقه. الإسلام دنيا ودين، حياة وعمل، وممارسة وتنفيذ، إيمان وتطبيق باليد واللسان والفكر يجادل الإسلاميون السياسيون ورجال الدين، وأكثر من هذا، فليس من إسلامي مسيس أو رجل دين مؤدلج إلا ويؤمن بان الدولة يجب أن تكون إسلامية والدين يجب أن يكون عمود هيكلها، والقرآن دستورها، والشريعة أساس وقاعدة قوانينها واحكامها وها قد رأينا بأعيننا ما حل في العراق فهل نفع الإسلام كدستور؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عدمُ تفهّمِ هذا التوفيقِ يعودُ إلى الخلفيّةِ الفلسفيّة التي ينطلقُ منها العلمانيُّ في فهمِه للإسلامِ، الأمرُ الذي يدعونا إلى مناقشةِ التصوّرِ الفلسفيّ الذي نتفهّمُ مِن خلالِه الظاهرةَ الدينيّةَ منَ الأساسِ، فتارةً يُنظرُ للدّينِ بوصفِه حقيقةً علويّةً مُتّجهةً منَ الأعلى إلى الأدنى، أي منَ السّماءِ الى الأرض، ومنَ الغيبِ إلى الشّهود، ومنَ الخالقِ إلى المخلوق. يمثّلُ الطّرفُ الأوّلُ مصدراً، والثاني مجرّدَ مُتلقٍّ، ومفهومُ الدّينِ الذي يتحقّقُ مِن هذا التصوّرِ، لا يخرجُ عن كونِه سلطةً فوقيّةً فُرضَت على الإنسانِ فرضاً، بغضِّ النّظرِ عن كونِها مُفيدةً له أو لا، المهمُّ هيَ سلطةٌ خارجةٌ عَن حدودِه وإرادتِه، ويجبُ على الإنسانِ الإلتزامُ بالدّينِ حتّى لو لم يفهَمه أو يرى في الإلتزامِ به ضرورةً، والذي يقاربُ الدّينَ مِن هذهِ الزّاويةِ سيجدُ تنافراً بينَ الدّينِ وبينَ شعورِه بالحريّةِ والإستقلالِ وهيمنتِه على نفسِه، وفي هذهِ النّقطةِ تبرزُ العلمانيّةُ كمُدافعٍ عنِ الإنسانِ ضدَّ السّلطةِ الفوقيّة.
وتارةً أخرى يُنظرُ إلى الدّينِ بوصفِه حقيقةً مُتّجهةً منَ الأدنى إلى الأعلى، ومنَ الأرضِ إلى السّماء، ومنَ الشّهودِ إلى الغيب، ومن المخلوقِ إلى الخالق، فهيَ فاعليّةٌ إنسانيّةٌ محضةٌ، ومفهومُ الدّينِ الذي يتحقّقُ مِن هذا التصوّرِ، لا يخرجُ عن كونِه تجربةً إنسانيّةً قائمةً على أساسِ تطلّعِ الإنسانِ وبحثِه عن الغيبِ سواءٌ كانَ له حقيقةٌ واقعيّةٌ أم لا، والدينُ في هذه الحدودِ لا يخرجُ عن كونِه تجربةً روحيّةً خاصّةً بالفردِ لا علاقةَ لها بالحياةِ السياسيّةِ والاجتماعيّة، وهذا ما تحاولُ العلمانيّةُ ترويجَه والدعوةَ إليه في الوسطِ الإسلامي.
وإذا نظرنا لكِلا البُعدين، نجدُ أنَّ البعضَ قد هاجمَ الدّينَ وإستبعدَه بناءً على البُعدِ الأوّلِ الذي يصوّرَ الدّينَ سلطةً فوقيّةً تصادرُ إستقلالَ الإنسانِ وحريّتَه وإرادتَه في هذهِ الحياة، وفي المقابلِ نجدُ البعضَ تفهّمَ الظاهرةَ الدينيّة، ولكن بالشّكلِ الذي لا يتصادمُ معَ العلمانيّة، فصوّرَ الدّينَ مِن خلال البُعدِ الثّاني، فحصرَه ضمنَ التّجربةِ الشخصيّةِ التي توفّرُ للإنسانِ فُرصةَ التّديّنِ الشخصي ولكن في نفسِ الوقتِ أبعدَه عن السّاحةِ العلميّةِ والمعرفيّة، كما أبعدَه عن ساحةِ المُساهمةِ في بناءِ حياةِ الإنسان.
وفي ظنّي أنَّ هناكَ بعداً ثالثاً يحقّقُ توازناً مِن نوعٍ آخر بينَ بُعدي الغيبِ والشهود، فليسَ الدّينُ هوَ هيمنةُ الغيبِ على الشّهود، كما أنّهُ ليسَ حركةً غيرَ واعيةٍ منَ الشّهودِ إلى الغيب، وإنّما هناكَ وسطٌ جامعٌ يلتقي فيه الغيبُ مع الشّهود، وحينَها يكونُ الدّينُ هوَ تعبيرٌ عن حركةِ الغيبِ إلى الشهودِ وحركةِ الشّهودِ إلى الغيب؛ ففي عُمقِ الشّهودِ هناكَ غيبٌ، وفي عمقِ الغيبِ هناكَ شهود، فعندَما يكونُ الشّهودُ حقيقةً غامضةً وهوَ كذلك، فلا سبيلَ إلى معرفتِه والتعاملِ معه إلّا على مستوى الظّاهر، وكلّما حاولَ الإنسانُ أن يفهمَ ما يقعُ خلفَ الظّاهرِ منَ الشّهودِ سوفَ يعجز، وتصبحُ كلُّ الإجاباتِ الممكنةِ هيَ التي تقودُه حتماً إلى تفسيراتٍ ترتبط بالغيبِ، ولذلكَ تصبحُ إلتفاتةُ الإنسانِ إلى الغيبِ إلتفاتةً حتميّةً لا مجالَ للهروبِ منها إلّا جحوداً وإنكاراً. وهذهِ الحيرةُ التي يعيشُها الإنسانُ وهذا الولهُ نحوَ معرفةِ الحقيقةِ دليلٌ على لُطفِ اللهِ الذي تدخّلَ وكشفَ للإنسانِ عمّا كانَ حائراً فيه. وبالتّالي لا يكونُ الدينُ سُلطةً قاهرةً وإنّما هو لطفٌ وتكرّمٌ على الإنسانِ يفهمُ مِن خلالِه الحقيقةَ الواحدةَ ذاتَ المظهرِ الغيبي والشهودي، أو المادّي والمعنى، أو الجسمِ والرّوح.
وإذا لم يكُن باستطاعةِ الإنسانِ الهروب من الدّينِ والإيمانَ باللهِ حينَها لابدَّ مِن إقامةِ حياتِه الفرديّةِ والاجتماعيّة على نظامِ القيمِ الذي يمثّلُ إرادةَ اللهِ في خلقِ الإنسان، وحينَها لا يكونُ الدّينُ مجرّدَ طقوسٍ شخصيّةٍ أو رياضاتٍ روحيّة تخدّرُ الإنسانَ وتمنعُه منَ التّفاعلِ الإيجابيّ معَ المُحيطِ الذي يعيشُ فيه، بل تجعلُ منَ الإنسانِ المحورَ الفاعلَ في بناءِ حضارتِه الروحيّةِ والماديّة، وبالتّالي النظرةُ التوفيقيّةُ التي يروّجُ لها العلمانيُّ تهدفُ إلى جعلِ الدّينِ ميتاً سريريّاً بحيثُ تحافظُ على نبضِ قلبِه مِن دونِ أيّ حركةٍ في بقيّةِ جسمِه، وهوَ الأمرُ الذي يتصادمُ مع حقيقةِ الإنسانِ المُنسجمِ ماديّاً وروحيّاً كما يتصادمُ مع فلسفةِ الدّينِ وجوهرِه القائمِ على تلكَ الحقيقةِ الإنسانيّة، وفي المُحصّلةِ خسارةُ الإنسانِ لإنسانيّتِه وكرامتِه بخضوعِه المُطلقِ لغرائزِه.
والمقاربةُ التي حاولَ السّائلُ الترويجَ لها، ليسَت إلّا تسطيحاً وتبسيطاً للقضيّةِ، فالخلافُ العلمانيُّ الإسلاميّ يعودُ بجذورِه إلى خلافٍ فلسفيٍّ له علاقةٌ بهدفيّةِ الإنسانِ وسرِّ وجودِه في الحياة، ولا يعودُ إلى مقارناتٍ مرتجلةٍ لبعضِ النّماذجِ السياسيّة هُنا أو هناك، فعندَما نقارنُ بين العلمانيّةِ والإسلام إنّما نقارنُ بينَ فلسفتين، فلسفة تستمدُّ جذورَها منَ المادّةِ وفلسفة أخرى توازنُ بينَ المادّةِ والرّوح، أمّا المقارنةُ بينَ المُسلمينَ وبينَ العلمانيّينَ كنماذجَ تطبيقيّةٍ ليسَت إلّا مخاصماتٍ سياسيّةً ونزاعاتٍ هدفُها الترويجُ والدّعاية.
وفي المُحصّلةِ يمكنُنا أن نقولَ أنَّ الإسلامَ منظومةٌ منَ القيمِ الهدفُ منها ضبطُ حركةِ الإنسانِ على مُستوى السّلوكِ الشّخصي أو الجماعي، وحرمانُ الإسلامِ منَ القيامِ بهذا الدّورِ يعني الحُكمَ عليهِ بالإعدام، ومِن هنا لا نقبلُ أن يتمَّ فهمُ الإسلامِ مِن خلالِ التّجاربِ سواءٌ كانَت تاريخيّةً أو معاصرةً وإنّما يجبُ فهمُه من خلالِ النّصوصِ التي تؤكّدُ ضرورةَ حضورِ القيمِ في الحياةِ الإنسانيّة، وعندَما يتمُّ فهمُ الإسلامِ ضمنَ هذا التصوّرِ ينفتحُ البابُ واسعاً أمامَ العقلِ الإنسانيّ بوصفِه المسؤولَ عن رصدِ الواقعِ وترويضِه بهذهِ القيم، فالإنفتاحُ الذي يمنحُه العقلُ على الواقعِ المُتغيّرِ يفتحُ الطريقَ أمامَ حداثةٍ إسلاميّةٍ أخلاقيّة تجعلُ المُسلمَ في غِنىً عن الحداثةِ الماديّةِ اللاأخلاقيّة.
فالدّستورُ لا يكونُ إسلاميّاً بمجرّدِ ذكرِ الإسلامِ كمصدرٍ في ديباجةِ الدّستور، وإنّما يكونُ إسلاميّاً عندَما يستوعبُ كلَّ المبادئِ التي جاءَ الإسلامُ مِن أجلِ جعلِها حاضرةً في حياةِ الإنسان.
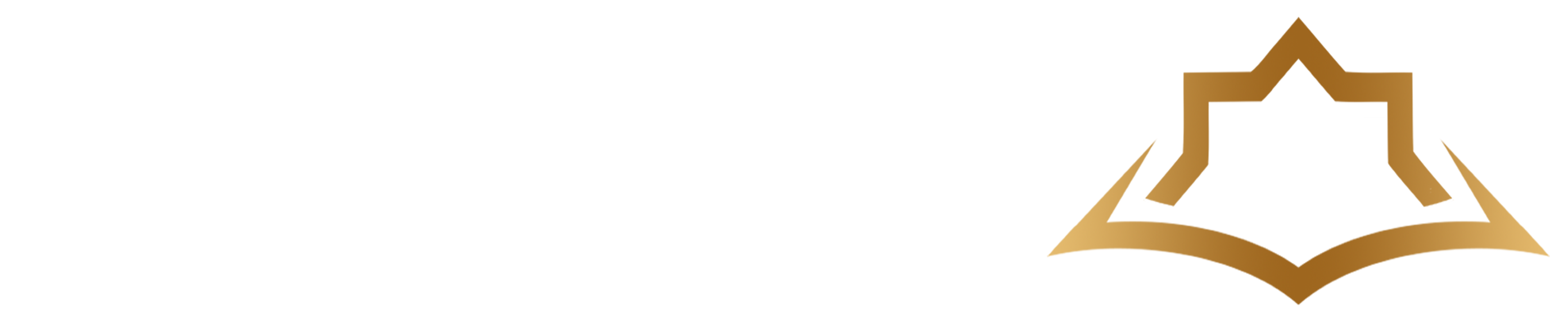

اترك تعليق