كيف نثبت حاجة المعصوم بعد النبي الاعظم (صل الله عليه واله)؟
الأخُ المُحترمُ، السّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ
الإمامُ عندَ الشّيعةِ لا بُدَّ أن يكونَ معصوماً منَ الخطأ، وهذا الشّرطُ هوَ الذي يُميّزُ الإمامَ عَن بقيّةِ المُسلمين، حتّى تكونَ لهُ أولويّةُ القيادةِ والإتّباعِ، ومن دونِ هذا الشّرطِ لا يمكنُ تسميتُه إماماً؛ لأنّهُ حينئذٍ يكونُ مأموماً لحاجتِه لمَن هوَ أفضلُ منه.
والعصمةُ قبلَ أن تكونَ ضرورةً شرعيّةً، فهيَ ضرورةٌ عقليّة، فالعقلُ يقضِي بوجوبِ إتّباعِ المعصومِ، كما يحكمُ بقبحِ تركِه وإتّباعِ غيرِه، وقَد تسالمَ بناءُ العُقلاءِ على أنَّ المرجعيّةَ المعصومةَ هيَ الطّريقُ الذي يُحقّقُ وحدةَ النّاسِ، وأنَّ السّببَ المُباشرَ لتشتّتِ الجهودِ واختلافِ النّاسِ هوَ تعدُّدُ القياداتِ، وهذا حكمٌ توافقَ عليهِ كلُّ العُقلاءِ، فلا يمكنُ توحيدُ أيّ مجموعةٍ منَ النّاسِ كبيرةٍ أو صغيرةٍ ضمنَ رؤيةٍ واحدةٍ وتوجّهٍ واحدٍ، إلّا بأن يكونَ على رأسِ هذهِ المجموعةِ شخصٌ واحدٌ، يُمثّلُ المرجعيّةَ الفكريّةَ لهذهِ المجموعةِ، ولا يمكنُ ضمانُ مسارِ هذهِ المجموعةِ من دونِ أيّ انحرافٍ، إلّا إذا إتّصفَ هذا القائدُ بالعصمةِ.
وهكذا الإسلامُ لا يمكنُ أن يكونَ واحداً، إلّا إذا كانَ هُناكَ إمامٌ معصومٌ يلتزمُ النّاسُ باِتّباعِه، كما لا يمكنُ أن تُحقّقَ الأُمّةُ الإطمئنانَ في مسيرِها، إلّا إذا كانَ على رأسِها معصومٌ.
فإذا خُيّرَ الإنسانُ المُسلمُ، بينَ أن يختارَ اللهُ لهُ إماماً معصوماً ليتّبعَهُ، وبينَ أن يختارَ هوَ لنفسِه إماماً مِن بينِ عامّة النّاسِ، فاختيارُ اللهِ هو الرّاجحُ عندَ كُلِّ عاقلٍ؛ لأنَّ العقلَ لا يجدُ سبباً للفُرقةِ بينَ النّاسِ، إلّا تعدّدَ القياداتِ التي تُمثّلُ خياراتٍ مُختلفةً، يمكنُ للنّاسِ اتّباعُها، ولا يمكنُ أن يتحقّقَ إجماعُ المُسلمينَ على إمامٍ واحدٍ، إلّا إذا كانَ هذا الإمامُ معصوماً ومُختاراً مِن قِبلِ اللهِ عزَّ وجل.
فتفويضُ الأمرِ إلى الأُمّةِ يؤدّي بشكلٍ قطعيٍّ إلى تعدّدِ الأئمّةِ، وهوَ السّببُ المُباشرُ لوجودِ هذهِ المذاهبِ، لأنَّ المذهبَ بإشارةٍ مُباشرةٍ هوَ إمامٌ لهُ أتباعٌ، وكُلّما تعدّدَتِ الأئمّةُ تعدّدَتِ المذاهبُ، ولو قطعَ الرّسولُ (ص وآله) الطّريقَ على الأُمّةِ، بأن عيّنَ لها أئمّةً أوكلَ إليهم أمرَ الدّين،ِ وأمرَ النّاسَ باِتّباعِهم فحينئذٍ لا يمكنُ أن نتصوّرَ أنَّ هُناكَ مذاهبُ وفرق.
وإذا حاولنا الرّجوعَ إلى واقعِ الأُمّةِ في العهدِ الأوّلِ منَ الرّسالةِ، لوجدناها أُمّةً واحدةً تحتَ زعامةِ الرّسولِ (ص وآله)، ولا يمكنُ أن نُفسّرَ هذهِ الحقيقةَ إلّا بالقولِ أنَّ الرّسولَ كانَ يُمثّلُ المرجعيّةَ المعصومةَ المُلتفَّ حولَها الجميعُ، وبالتّالي فإنَّ وجودَه الشّريفَ كانَ هو الضّامنَ لوحدةِ المُسلمين، فكانَ بمثابةِ صمّامِ أمانٍ لهذهِ الأُمّةِ، وبمُجرّدِ ما انتقلَ الرّسولُ (ص وآله) إلى الرّفيقِ الأعلى، إنفرطَ شملُ الأُمّةِ، وانفلتَ عقدُ وحدتِها مِن بعدِه.
ولو فرضنا جدلاً، أنَّ اللهَ أطالَ في عُمرِ نبيّنَا الأكرمِ (ص وآله) إلى يومِنا هذا، فهَل يمكنُ أن نتصوّرَ وجوداً لهذهِ الفرقِ والطّوائف؟.
كذلكَ الحالُ لو فرضنا وجودَ إمامٍ معصومٍ، مُعيّنٍ مِن قبلِ اللهِ ورسولِه، فحينئذٍ لا يمكنُ تصوّرُ أيّ فِرَقٍ أو طوائفَ، إذ يُمثّلُ هذا الإمامُ المِحورَ الذي تدورُ حولَه الأُمّةَ، الأمرُ الذي يجعلُنا نحكمُ يقيناً بأنَّ إيمانَ الشّيعةِ بضرورةِ المعصومِ، إيمانٌ ينطلقُ منَ الحرصِ على مُستقبلِ الرّسالةِ ووحدةِ المُسلمين، فلَم يُسلَّ سيفٌ بينَ المُسلمين إلّا بسببِ تضييعِ الإمامةِ، واستبعادِ الأُمّةِ لهذا الخيارِ، الأمرُ الذي جعلَ الأُمّة مسؤولةً عن هذا التّشرذمِ والإختلافِ؛ لأنَّ الضّمانَ الوحيدَ الذي يُحقّقُ وحدةَ الأُمّةِ هوَ القيادةُ المَعصومةُ.
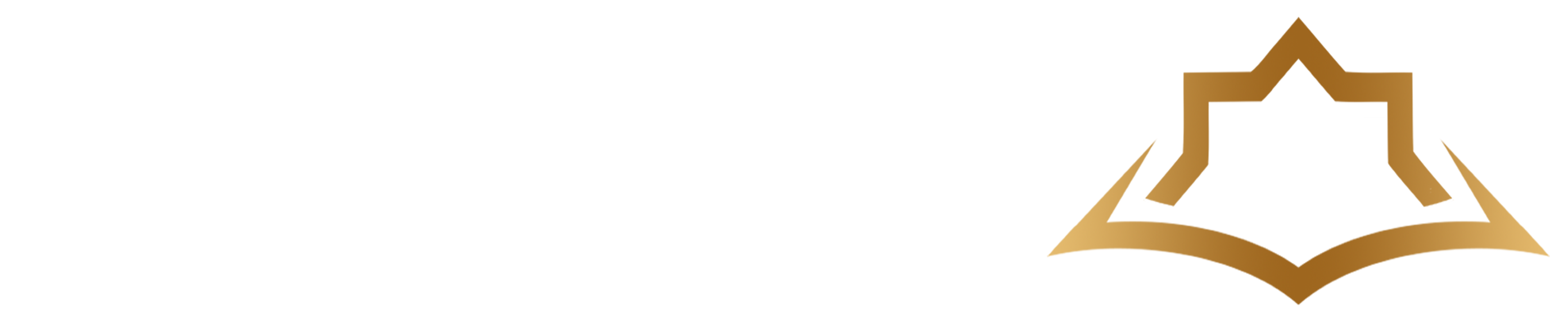

اترك تعليق